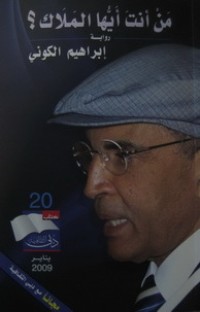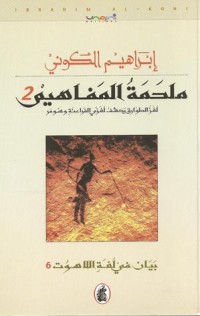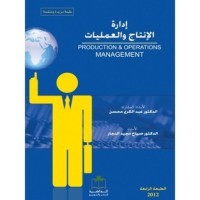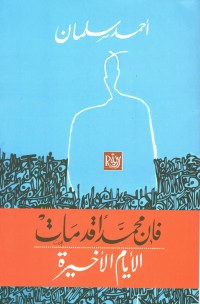باعتناقنا لتميمة سقراط نشبع نهم فضولنا الإنساني الظامئ دائماً لأن يقول، ولأن يسمع مقابل ما يقول، ولكنّا في الصفقة نضل السبيل إلى الخافية، إلى الجوهر، نفقد تلك الحقيقة التي تقول فلسفات "الزن" أنها تقع في مكان ما خارج الكلمات، لا لأن ما نقول ما هو إلا ظل لما لم نقله، ظل لما أعجزتنا
عضلة اللسان عن قوله، ولكن لأن القول في حد ذاته يتستر على طبيعة استسرارية تحول القول إلى لغز، أو طلسم، في أحسن الأحوال، كما تحوله إلى ابتذال، في الحال الأسوأ. ولهذا فإننا بالقول لا نرتكب الخطيئة فحسب، ولكنا لا نقول ما نريد أن نقوله أبداً. وهو مأزق ليس ناجماً عن استعصاء الكلم، أو إعجاز العبارة، كما قد يظن بعض البلهاء، ولكنه مأزق ديني أساساً مأزق ناجم عن السجية الميتافيزيقية للكلم أساساً. وخطورة الكلم إنما تنتج عن هذه الطبيعة الميتافيزيقية بالذات. ولهذا نفهم لماذا استحق الأمر الإلهي القاطع: "اقرأ!" جواباً قاطعاً أيضاً حتى أنه يبدو تجديفاً في حق الربوبية من صاحب الرسالة في عبارة: "ما أنا بقارئ!" التي فسرت كجهل من الرسول بسر القراءة، في حين يجب تأويلها كما يجب أن تؤل، أي التنصّل من الأمر خوفاً من الحقيقة المستخفية وراء الأمر، فزعاً من قدر النبوة المتخفي خلف ستور القراءة. وهو فرار حدثتنا المصادر عن مثيل له يوم فر النبي من وجه الملك جبريل إلى خديجة في أول تجربة له مع النبوة ليخفي وجهه في حضنها مردداً: "دثريني! دثريني!". وهو فرار له ما يبرره، لأننا لن نعدم أن نجد له رديفاً في أول تجربة لإنسان بكر يذهب إلى ساحة العرفان لأول مرة (أعني ما نسميه مدرسة بلغتنا اليوم). إبراهيم الكوني مزيج من خيالات وأحاسيس ومعان يتدفق تشكيلات حروف، وسيالات عبارات لا يستطيع المرء حيالها سوى التأمل ملياً بإبداع ذاك الكاتب الذي يتجاوز حد المألوف في المقروء والمفهوم والمنسوج في عالم الأدب القصصي والروائي. ففي صحفه الأولى يرحل بنا الكاتب إلى عالم من أفكار تقفز برشاقة من خلال عباراته الرائعة ومعانيه الشفافة، لتحتل دواخلنا، ولتنشر في النفس نشوة أدبية لطيفة، ولتثري العقل بأفكار تصل إلى حدّ الغرابة الرائعة.