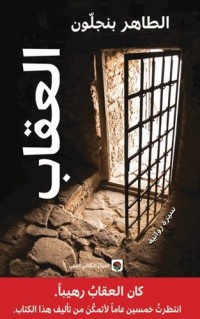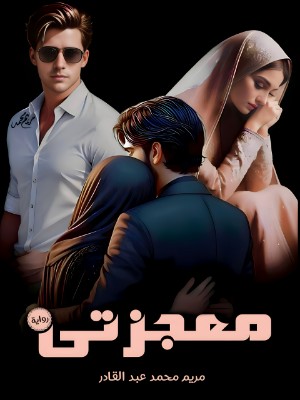كان هناك جمهور غفير ذلك اليوم، الجمعة، في مسجد مولاي إدريس في "فاس" كان الجو حاراً ورطباً وثقيلاً، يشعر المرء خلاله بالاختناق كما لو أن رئتيه قد امتلأتا بسائل ثقيل وعكر، والسماء تكاد تبدو صفراء،
وقد حجبت السحب الشمس. المدينة ترزح تحت وطأة القرون التي توالت عبر الصمت والسأم، وتزداد هبطاً وغوصاً في الخزف والفخّار "فاس" المدينة القديمة، مدينة المدن، تنفرد في عزلتها، تجمع ركامها وأنقاضها، مستسلمة بلا مبالاة لسبات عميق، تاركة مساجدها مفتوحة للصلوات. كانت تتصنع في ذلك اليوم الجمعة من شهر آب، غصّ مسجد مولاي إدريس بشباب متحمسين قادمين من الجبال السهول، يرتدون الملابس البسيطة وقد حلقوا لحاهم بصورة متشابهة. كانوا يرتلون ويفرضون إيقاع التجويد في تلاوة القرآن. كما أن الشيخ الذي يؤم الصلاة لم يكن "فاس" أيضاً. كانت لحيته كلحية أولئك الشباب، فلا بد أنه مرشدهم وموجه تفكيرهم. فقد ألقى بلهجة قوية وآمرة موعظة استنكر فيها غرور الأقوياء وفقدان الكرامة لدى أولئك الذين ألفوا التعرض للحذلة يومياً. وأصغى الجميع إليه بصمت عميق,. وبعد الصلاة المهيبة دعا الحضور لتأدية صلاة الغائب دون أن يحدد أو يوضح شيئاً. كان ذلك بمثابة الأمر، فنهض الناس جميعهم في حركة واحدة، وشكلوا صفوفاً متراصة، متوازية، ومتناسقة. وفي المحراب، قبالة الشيخ، لم يكن هناك بالتأكيد أي جثمان. هذا هو المبدأ نفسه لهذه الصلاة غير العادية. ودون سجود أقيمت الصلاة على أجساد غائبة، أجساد مجهولة الأسماء، اختفت بعد أن طوتها أرض بعيدة، وكفنتها وحدة ووحشة الرمال أو مياه بحر متلاطم الأمواج". بدأت فصول هذه القصة في مدينة مقدسة مدنسة، هي مدينة "فاس" بعد أن حكمها المستعمر وانتشر فيها وباء الحمى الصفراء. تردي القصة مولد طفل "محتار" عبر رحلة تنتهي على مشارف الصحراء الكبرى التي تسكنها ذاكرة الولي الثائر الشيخ "ماء العين". ولعلها رحلة المغرب البائس الجائع، الباحث عن الأمل. يلخص من خلالها الروائي، وبإطار رمزي، ماضي الاستعمار ولا بؤس والانحطاط الموروث منه. وما تزال بقاياه في ذاكرة الشعب حتى يومنا هذا. هذا اللغز، لغز الماضي الغائب الحاضر، هو ما يعطي لرواية الطاهر بن جلون قيمتها وجوهرها الاجتماعي والتاريخي
كان هناك جمهور غفير ذلك اليوم، الجمعة، في مسجد مولاي إدريس في "فاس" كان الجو حاراً ورطباً وثقيلاً، يشعر المرء خلاله بالاختناق كما لو أن رئتيه قد امتلأتا بسائل ثقيل وعكر، والسماء تكاد تبدو صفراء،
وقد حجبت السحب الشمس. المدينة ترزح تحت وطأة القرون التي توالت عبر الصمت والسأم، وتزداد هبطاً وغوصاً في الخزف والفخّار "فاس" المدينة القديمة، مدينة المدن، تنفرد في عزلتها، تجمع ركامها وأنقاضها، مستسلمة بلا مبالاة لسبات عميق، تاركة مساجدها مفتوحة للصلوات. كانت تتصنع في ذلك اليوم الجمعة من شهر آب، غصّ مسجد مولاي إدريس بشباب متحمسين قادمين من الجبال السهول، يرتدون الملابس البسيطة وقد حلقوا لحاهم بصورة متشابهة. كانوا يرتلون ويفرضون إيقاع التجويد في تلاوة القرآن. كما أن الشيخ الذي يؤم الصلاة لم يكن "فاس" أيضاً. كانت لحيته كلحية أولئك الشباب، فلا بد أنه مرشدهم وموجه تفكيرهم. فقد ألقى بلهجة قوية وآمرة موعظة استنكر فيها غرور الأقوياء وفقدان الكرامة لدى أولئك الذين ألفوا التعرض للحذلة يومياً. وأصغى الجميع إليه بصمت عميق,. وبعد الصلاة المهيبة دعا الحضور لتأدية صلاة الغائب دون أن يحدد أو يوضح شيئاً. كان ذلك بمثابة الأمر، فنهض الناس جميعهم في حركة واحدة، وشكلوا صفوفاً متراصة، متوازية، ومتناسقة. وفي المحراب، قبالة الشيخ، لم يكن هناك بالتأكيد أي جثمان. هذا هو المبدأ نفسه لهذه الصلاة غير العادية. ودون سجود أقيمت الصلاة على أجساد غائبة، أجساد مجهولة الأسماء، اختفت بعد أن طوتها أرض بعيدة، وكفنتها وحدة ووحشة الرمال أو مياه بحر متلاطم الأمواج". بدأت فصول هذه القصة في مدينة مقدسة مدنسة، هي مدينة "فاس" بعد أن حكمها المستعمر وانتشر فيها وباء الحمى الصفراء. تردي القصة مولد طفل "محتار" عبر رحلة تنتهي على مشارف الصحراء الكبرى التي تسكنها ذاكرة الولي الثائر الشيخ "ماء العين". ولعلها رحلة المغرب البائس الجائع، الباحث عن الأمل. يلخص من خلالها الروائي، وبإطار رمزي، ماضي الاستعمار ولا بؤس والانحطاط الموروث منه. وما تزال بقاياه في ذاكرة الشعب حتى يومنا هذا. هذا اللغز، لغز الماضي الغائب الحاضر، هو ما يعطي لرواية الطاهر بن جلون قيمتها وجوهرها الاجتماعي والتاريخي