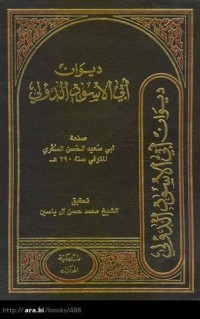كتاب تنظير التغيير بقلم محمد أحمد الراشد

2023-01-03
مفاهيم أزعجتني في بعض كتب الراشد
أ.د. منذر سليم عبد اللطيف
monzir394@gmail.com
أعدت تصفح بعض كتب المؤلف والمفكر الإسلامي البارز ، المعروف في أوساط الإسلاميين الأستاذ محمد أحمد الراشد ، والذي أكن له كل احترام وتقدير. وعلى رأس تلك الكتب كتاب تنظير التغيير ، الدافع الرئيسي لكتابة السطور أدناه ، حيث سأتناول بعض ما جاء فيه من مفاهيم أختلف معه فيها. وكذلك ما لفت انتباهي من قضايا فكرية واجتهادية أرى أنها لا زالت مشوشة ومضطربة في الفهم التقليدي للإسلام الحركي ، والتي لا أجد حرجاً في التعبير عن أختلافي مع الكاتب في تفاصيلها ، ولا أخفي أنني بذلت كثيراً من الوقت والجهد في محاولة نقدها منذ عقود. أيضاً ، سوف أقوم بالتعقيب ونقد بعضاً مما ورد في كتابات أخرى للمؤلف ، بالذات تلك المفاهيم المتعلقة بفلسفة التغيير والتي أراها مقلقة وليست في محلها ، ولا بد من إعادة النظر فيها ، إذا أرادت الحركة السير قدماً ، والتخلص من بعض الأوهام التي تآلفت معها عبر السنين ، والخروج من الحلقة المفرغة التي لا زالت تتخبط فيها منذ نشأتها.
وأبدأ بكتاب تنظير التغيير ، حيث تم تقديم الكتاب على أنه يمثل النظرية التكاملية للتغيير السياسي الإسلامي ، وحيث أنني مهتم بدراسة فلسفة التغيير فقد قرأت الكتاب بتمعن ، واطلعت على نظرة الكاتب وطريقة معالجته لهذا الموضوع ، الذي كان ولا زال يمثل في رأيي نقطة أساسية من نقاط ضعف الفكر التعبوي النظري والعملي للحركة الإسلامية ، وكان ولا يزال – من وجهة نظري – من أبرز مسببات الاشتباك السلبي سواء مع الأنظمة الرسمية أو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الأخرى.
وللأسف الشديد ، فبدلاً من توضيح الفكرة وبسط عناصرها ومناقشة مفاهيمها وترتيب صياغاتها فإنني لم أجد سوى مجموعة من الأطروحات الهلامية المتشابكة التي غلب عليها الأسلوب الإنشائي والجمل التصويرية التي يتميز بها أسلوبه الكتابي ، وقد رأيت أنها تحوي في ثناياها بعضاً من التناقضات وغاب عنها التحديد والوضوح الذي كان الأولى في مثل تلك الدراسات العلمية الهامة ، لأن الموضوع من المفروض أنه لا يتعلق بالحماسة وشحذ الهمم بقدر ما يعالج التأصيل ومخاطبة العقل وقوة المنطق ، بالذات عند الحديث عن فلسفة التغيير أو مرتكزات التنظير للتغيير السياسي الإسلامي ، بما ينسجم مع الفكر الإسلامي في أجواء الحداثة والواقع.
لكن من المؤكد أنني استمتعت بقراءة العديد من مؤلفات السيد الراشد ، وما يأتي به من الصياغات الأدبية المميزة ، والأشعار الرائعة التي يسوقها بين ثنيات موضوعاتها ، ولا يمكن لمنصف أن يقلل من شأن وتأثير تلك الكتابات في موضوعات التربية وتقويم السلوك ، وشحذ الهمم ، وبث الحماسة والتفاؤل والتدين ، لكن هذا لا يعني القبول والتسليم بكل ما يورده ، إذ لا أحد معصوم في المسائل الاجتهادية ، بالذات في موضوع يتعلق بالمصلحة العامة والفكر السياسي والتغيير.
يبدأ الكاتب عرضه بمقدمة غريبة أعتقد أنها تلخص ما جاء في الكتاب من تلاطم أفكار تفتقر إلى التسلسل المنطقي والتركيز المعرفي ، فيذكر في صفحته الأولى أن موضوع الكتاب بمجمله كان عبارة عن محاضرة طويلة خاطب فيها عشرات من قيادات الدعوة ، واستغرقت ساعات عديدة ، وذلك بعد سقوط حكمي مبارك وبن علي ، ويشير أنه قد تم تصوير المحاضرة بشكل تقني عالي المستوى ، إلا أنها ضاعت!!!. وهنا استوقفتني أمور عدة ، منها:
أن الكاتب أراد لهذه المحاضرة أن تشيع بين العرب والعجم لأهميتها بحسب قوله ، وهذا تقدير مقبول من الكاتب إذ يمكن تبريره على المستوى الشخصي نظراً لشعوره بأهميتها ، لكن ليس مفهوماً كيف يمكن لمثل هذه المحاضرة الفيصلية والهامة أن تضيع ، بالرغم من أن المتحدث والحضور من أكبر قيادات الحركة الإسلامية ، وإذا لم تتمكن تلك القيادات من المحافظة على تسجيلات محاضرة واحدة فهل من الممكن أن يدعي الكاتب أو غيره التنظير للتغيير؟ وقد يستغرب القارئ من موضوع ضياع المحاضرة ، إلا أن ذلك يذكرني بحديث جرى بيني وبين أحد قيادات الحركة الإسلامية ، كان يدلل فيه على مدى العناية الربانية بالحركة ، ويذكر أنه أثناء سفره جواً إلى كندا في ثمانينيات القرن الماضي وبعد وصول الطائرة تبين له وصول جميع متاعه إلا حقيبة واحدة لم تظهر ، وللأسف فقد كانت تلك الحقيبة تحوي كامل معلومات التنظيم في بلده. وبعد طول انتظار في صالة الحقائب لم يجد بداً من التقدم بإفادة فقد حقيبة ومن ثم مغادرة المطار ، ليكتشف بعد أيام وقوعها في يد موظف صومالي الأصل يعرف العربية ، فحافظ عليها وأعادها كاملة سالمة إلى ذلك القيادي. وأردف يحدثني عن قيادي آخر من بلده تم اقتياده فجأة من الشارع إلى فرع المخابرات ومعه حقيبة فيها أسماء وعناوين جميع أعضاء التنظيم في مدينته ، في الوقت الذي كان الانتساب فيها للحركة يعني "الإعدام" في حينه ، وتعرض للتحقيق والاستجواب إلا أنهم لم يطلبوا منه فتح الحقيبة ولم يفتشوها ، لحسن الحظ!!! ، وإلا كانت حلت كارثة لا يعلم مداها إلا الله. فهل معنى ذلك أن التغيير المنشود يراد له أن يعتمد على الحظ ، وبالرغم من أنه ممكن أحياناً ، إلا أن ذلك ليس من طبيعة الأمور. وفي الواقع ، كنت أتمنى أن أعلم كيف تم معالجة أمر فقدان المحاضرة ، لأطمئن إلى استحداث الحركة الإسلامية آليات مناسبة تقودها إلى تغيير النمط.
أيضاً ، يذكر الكاتب في ذات السياق أنه أصيب بالذهول شهوراً بعد معرفته بضياع المحاضرة ، فأضرب عن الكلام حتى شفع شافعون ، فكتب الكتاب الذي نناقشه. ويستطيع القارئ عند مطالعة مقدمة الكاتب التخمين أنه كان يرتجل الكلام في موضوع التغيير ارتجالاً لساعات ، ولم تكن لديه نسخة ورقية فاستعاض عن كل ذلك بكتابة الكتاب ، وهو أمر لا يليق بكاتب أو منظر كبير يتحدث عن موضوع عظيم أن يرتجل بهذه الطريقة ، لدرجة أن يتملكه الحزن على ضياع التسجيل لاحتوائه على أجواء المحاضرة وما تخللها من حماسة (لا يتطلبها التنظير للتغيير في حضور قيادات العمل الإسلامي). ثم يعبر الكاتب عن سبب حزنه بأنه لا يقبل افتعال الحماسة التي تملكته عند إلقائه المحاضرة أول مرة إذا ما قام بإعادة تسجيل المحاضرة. وهو أمر غريب ، لأن الداعية قد يقوم بإلقاء محاضرة في مكان ، ثم يعود ويلقيها في مكان آخر لمجموعة ثانية وثالثة ، فتزداد المحاضرة عمقاً ويزداد المحاضر إلماماً وتمكناً ، وليس فيه تزوير ولا غيره إن كان بعيداً عن التنمق والتكلف ، وفي رأيي أن تلك الأوصاف التي ساقها الكاتب للتعبير عن غضبه وحزنه كانت متكلفة أكثر من اللازم ، ولم يكن لها ضرورة ، أو أنها انعكاس لطبيعة الكاتب العاطفية الجياشة (كما أظن). أيضاً أرى أنه من غير المبرر استخدام أساليب الحماسة وارتفاع الصوت والضرب على المنضدة (كما ذكر الكاتب) في وجود قيادات ، وليس مجموعة من الأفراد العاديين ، فالقيادة تحتاج إلى الحديث بروية وإعمال العقل والتفكير للوصول إلى نتائج ، بعكس الرعاع والأتباع من الصفوف الدنيا الذين تحركهم العواطف ويحتاجون إلى الخطاب الحماسي. كل ذلك يؤشر إلى عدم الروية والتمعن في الاستنتاجات التي سيسردها الكاتب في الفصول المبعثرة ، حيث يفتقر الكتاب إلى الفهرس المناسب ، مما أضفى عليه طابع التشتت والتفكك والفوضى.
ويتابع الكاتب في نهاية الصفحة الأولى فيقول بأن نجاح الثورات في مصر وتونس وليبيا أوجب صياغة نظرية التغيير لتكون هادية لثورات أخرى ولثورات يجب أن تقوم في كل بلاد العرب وإيران والكثير من بلاد المسلمين!!!. وهنا لا بد من تسجيل بعض النقاط التي أعتبرها جوهرية في الخطاب الإعلامي والسياسي للإسلاميين. أول تلك النقاط أنه ليس من المنطق ولا المعقول إظهار الشماتة في الأموات من الساسة الذين سقط حكمهم ، بالذات إذا لم تتم إدانتهم في محاكم عادلة ، لأنهم خصوم سياسيون ليس إلا. وأرى أنه ليس من الإنصاف ولا المروءة الحديث عن أحدهم أنه لجأ إلى نفق المجاري أو أنه أظهر الجبن ، أو وصف حاكم اليمن أنه جاهل اليمن وغيرها ، فهذه الأوصاف لا علاقة لها بالموضوع ولا تقدم أية إضافة ، بل تستثير عداوة أنصاره ومؤيديه وقبيلته ، وتجعل من التحالفات السياسية أكثر صعوبة ، وتثير الشك والريبة في الإسلاميين ومستقبل حكمهم ، فضلاً عما قدمه بعض هؤلاء من دعم ورعاية للعديد من قضايا الأمة. ومن الممكن استحضار قصة حقيقية توضح ما حدث نتيجة سوء تقدير لجهاز أمن حركة إسلامية كبيرة في التعامل مع أحد أعيان إحدى العائلات ، حيث قامت الحركة بامتهان كرامته والاعتداء عليه داخل ديوان (مقر) عائلته ، مما اعتبرته العائلة إعتداء عليها ، فلم تخسر الحركة خيرة شبابها من أبناء تلك العائلة فقط ، بل ناصبوها العداء.
كما أن الدعوة إلى قيام الثورات في كل البلاد العربية وغيرها يعتبر من وجهة نظري سذاجة مفرطة وخطأ لا يغتفر ، إذ من المعروف أن لكل قطر ظروفه الخاصة ، وما ينسحب على بلد معين ليس بالضرورة أن ينسحب على بلد أو بلاد أخرى ، والأهم من ذلك أن مثل هذا الكلام قد يحسم أمر الكثير من الأنظمة في عداوتها للحركة الإسلامية ، إذ تشكل مثل هذه الدعوات (التي لا تسمن ولا تغني من جوع) ذريعة مبكرة للعمل ضد تلك الحركات دون فائدة تذكر ، بعد أن كشف الكاتب نياتها ، وصرح أن قادتها ينتظرون الفرصة ويتربصون بالبلاد للنيل من حكوماتها وأنظمتها ، وليس من الواضح إن قصد الكاتب شيئاً آخر.
كما يستطرد الكاتب بالدعوة إلى الاستعجال وأخذ زمام المبادرة قبل أن تستثمر تلك الظروف الناضجة مجموعات ساذجة ليس لها فقه ثوري. ويدعو المؤلف المجموعات الدعوية إلى أخذ زمام المبادرة وفق خطط ونظرية مؤصلة شرعاً ومنطقاً ، وعلى خلفية تجريبية وافرة ، وتعليلات فلسفية من علم الحياة!!!. وفي تلك الدعوات أفخاخ وافتراضات لا أساس لها من الصحة. فبدلاً من دعوة المؤلف إلى التعاون وبناء أرضيات مشتركة مع قوى التغيير المختلفة ، فإنه يصرح بتوجسه وخوفه منها ، ودعوته إلى تصدر المشهد ، بأي ثمن ، خوفاً من سذاجة تلك القوى أو تحسباً لوقوع الحركة الإسلامية أو الثورة ضحية الانتهازية ، وهذا بحد ذاته مغاير لحركة الحياة القائمة على التعاون للوصول إلى الحقوق المشتركة. ثم أين هي الخلفية التجريبية الوافرة لدى الإسلاميين في الثورة ، وأين هي الصورة الواقعية التي توضح طريقتهم وفلسفتهم في الحكم؟ للأسف ، مجرد الفاظ وكلام لا منطق فيه ، وهو دعوة للقضاء على ما تبقى من مصداقية للحركة الإسلامية ويضر بها أكثر من كيد أعدائها ، وما هو إلا ترجمة حرفية للفكر المشوش للتغيير في عقلية الحركات الإسلامية ، إن صح التعبير.
ثم يعبر المؤلف عن إيمانه وقناعته التامة أن النصر والتمكين للجيل الإسلامي الحاضر حاصل لا محالة بالرغم مما يعتري هذا الجيل من نواقص وخلل في مواطن كثيرة ، إذ يكفي أن تكون هناك فئة قليلة من الدعاة الأنقياء المخلصين حتى يتحقق التمكين. وأرى أن هذا القول أيضاً لا يصح ، فالتغيير هو سنة كونية (كما يشير المؤلف في موضع لاحق) ، وسواء كان هناك مخلصين أم لم يوجد ، فالمجتمعات تشيخ ويحدث التغيير بشكل طبيعي أو بالثورة. لكن أخشى ما أخشاه أن يكون المؤلف يقصد أن تتولى تلك الفئة المخلصة القليلة والنقية الحكم في البلاد ، أو أن التغيير في وجودها يقتضي تصديرها بشكل طبيعي للحكم ، وفي هذا الفهم خلل لا يمكن التسامح معه. وحتى في المنهج الإسلامي المعتبر ، فإن الشورى أو الانتخاب يعتبر المسوغ الأساسي للحكم في الأوضاع العادية الأقرب إلى مجتمعاتنا الحالية ، وليس شرطاً بالطبع أن يتم اختيار المخلصين الأنقياء. والسؤال: إذا حصل التغيير وسقط الطغاة ، وفي نفس الوقت لم يحكم المخلص النقي فهل يعتبر المؤلف أن التغيير الحاصل إيجابي أم أنه بحاجة إلى تغيير؟
إن الدعوة إلى التغيير ليست مقتصرة على فئة من المجتمع دون أخرى ، وبديهي أن الإسلاميين ساهموا في تكوين ثقافة التغيير ، لكنهم لم يكونوا الوحيدين. وعلى الحركة الإسلامية بداية الاعتراف أنها جزء من حركة المجتمع وليست كل المجتمع ، بل لها شركاء بالرغم من أنهم ناصبوها العداء الفكري ، واختصموا معها في مواطن وأزمنة كثيرة ، ولا يقتنعون بقدراتها ولا نياتها ، لكنهم أثروا الساحة بأفكارهم ودعواتهم إلى التغيير ، ولديهم مؤسسات قوية قائمة ، وليس هناك مناص من البحث عن القواسم والأهداف المشتركة ، وسبل التعاون مع تلك القوى ، للوصول إلى تلك الأهداف التي تحقق المصلحة العامة. كما يجب الاعتراف أن الله خلق الناس مختلفين ، وبعد أن أصبحت هناك قناعة لدى الإسلاميين بتداول السلطة والاحتكام إلى صندوق الاقتراع ، فقد أصبح من السهل التعاون مع الجميع ، وعليه فإن القاعدة الذهبية التي يجب أن تعيها الحركة الإسلامية تقول بأن الحركة لا يمكن أن تدعي أحقية الحكم منفردة بحجة أنها حركة إسلامية تحتكر الصواب وتمتلك الحقيقة المطلقة ، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن مجرد التسليم بمبدأ الحق في تداول السلطة وأن الشعب هو المفوض الوحيد للسلطات (وليس صلاح الفرد أو انتماؤه إلى الحركة الإسلامية) ، والدفاع عن هذا المبدأ يعتبر حجر زاوية في فهم دور الحركات الإسلامية في التغيير ، كما يفتح الباب على مصراعيه للتحالفات السياسية ، بما يختصر الطريق نحو الحرية المنشودة ، والشعب هو الذي يختار ، واختياراته تُحترم.
ولعل الكاتب يشير إلى بعض تلك المعاني فيقول أنه لو حرص الدعاة المخلصون على التعاون والتكامل مع أرباع وأنصاف حملة المعاني الإيجابية من تعاليم الإسلام لكان الوصول إلى الحرية أسرع بكثير ، بل يذهب المؤلف إلى شرعنة التدرج في الوصول إلى الحكم الإسلامي ، وبين أن ذلك يمر بتوفير الحريات العامة والحقوق السياسية وتشجيع المواهب والنهوض الصناعي ، ثم يكون من بعد ذلك إعلان تطبيق الشريعة والأحكام!!!. وبالرغم من البدايات المشجعة للمؤلف حول ضرورة الاهتمام بمناحي الحياة المختلفة التي تضمن الحريات والكرامة والتقدم ، إلا أنه يختم ذلك بإعلان تطبيق الشريعة والأحكام ، وهو أمر لا مفر من اعتماده من الشعب إما بالاستفتاء أو بانتخاب أغلبية ساحقة من الحركة الإسلامية ، وعليه يعتبر هذا الموضوع تحصيل حاصل في تلك الأحوال ، وإن مجرد سوقه هنا يدعو إلى الريبة. والسؤال: ماذا لو فازت الحركة الإسلامية بالأغلبية وأعلنت عن تطبيق الأحكام الشرعية ، ثم بعدها بسنوات قليلة خسرت الانتخابات وتم إلغاء تطبيق الشريعة ، فما هو موقف الحركة الإسلامية حينها؟ إن موضوع تطبيق الشريعة ليس موضوعاً ذا مغزى في بلادنا الإسلامية أصلاً ، والتي تطبق فيها معظم الشرائع الإسلامية ، لكن المتمعن في الموضوع قد يستنتج أن الموضوع سياسي في أصله ، لكنه يرتدي اللباس الديني ، ربما لأسباب سياسية ، حيث أقر الكاتب بإمكانية تأجيل وتدرج تطبيق الشريعة. إن فهم الحركة الإسلامية للشريعة وتطبيقاتها في الحياة يجب أن يكون أكثر انفتاحاً واتساعاً ، ويجب ألا يبقى مصطلح تطبيق الشريعة من المصطلحات الفضفاضة ، بل يجب تحديد القضايا الشرعية بدقة ، وما كان خاضعاً للحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الخاصة أن يتم إدراجه تحت هذا البند ، وما كان خاضعاً للمخدرات أو الخمر أن يندرج تحته ، وهكذا ، مع دراسة كل تلك الأمور بانفتاح ومرونة بما لا يمس أصول وجوهر الدين ، ومن الممكن استخدام التحالفات السياسية لتحقيق الكثير من القضايا المتناثرة التي تعتبر جزءاً من الشريعة.
إن اعتراف المؤلف بأهمية التدرج والعمل على إنجاز العديد من الأمور الخاصة بالحكم الرشيد هو أمر جيد ، لكن استنتاجه أن نهاية المطاف تقتضي الإعلان عن تطبيق الشريعة يوحي أن هناك ضبابية واضحة وخلط بين المقدمات والنهايات ، لأن المقدمات تعتبر من أعمال الحركات والأحزاب السياسية ، أما الإعلان عن تطبيق الشريعة فهو أمر آخر يقتضي موافقة العامة والمؤسسات المختصة ، وهو أمر لا تقضي به الحركة الإسلامية ، حتى لو وصلت إلى الحكم بطريقة شرعية.
بعد ذلك يقر المؤلف أن التكوين والتعبئة الثورية شارك فيها الإسلاميون والعلمانيون وكثير من الأحرار غير المنتمين من سائر المشارب والتخصصات ، كلهم أسهموا في بناء الشخصية الثورية ، وهي شهادة محترمة ، يتبعها كم من الحواشي والأمثلة التي لا تمت بصلة لنظرية التغيير السياسي. لكن لعل الأهم من ذلك الإجابة على التساؤل: ما دام شارك الجميع في بناء الشخصية الثورية واسهموا في تهيئة الأرضية المناسبة للثورة ، فهل المنطق أن تنفرد جهة دون غيرها في الحكم ، ومن الذي يقرر طبيعة الحكم والحاكمين؟ من المؤكد أن يسهم الجميع في الحكم كل بحسب حجمه والتفويض الذي يمنحه له الناخبون ، وأن مطالبة جهة معينة بالانفراد في الحكم يعتبر خيانة للمجموع ، ومحاولة لمصادرة جهودهم وغمطهم حقهم وإسهاماتهم.
عوامل التصعيد التي أدت إلى الثورات
يذكر المؤلف تسعة من العوامل يعتبر أنها الأكثر تأثيراً في اندلاع الثورات ، ويدعي أن الدعوة الإسلامية بكل جماعاتها قدمت من خلال مفكريها "نظرية تامة كاملة للتغيير الآمن المنضبط بقواعد التخطيط والحكمة العقلانية" وهو كلام غريب ولا رصيد له على الإطلاق من وجهة نظري ، إذ لم يعدُ ما تم تقديمه مجموعة من الوعظيات والتذكير بأمجاد السلف مختلطاً بالكثير من قصص العدل والبطولة ، لكن الإنصاف يقتضي الإقرار أن معظم المشاركين سواء في الثورة المصرية أو التونسية لم يكونوا أصلاً من التيار الإسلامي ، وحتى أبناء الحركة الإسلامية لم تكن لديهم وليس لديهم إلى اليوم ما يمكن أن يطلق عليه خطة جاهزة للتغيير ، فكيف يدعي المؤلف أن الجماعات الإسلامية (المختلفة والمتناحرة أصلاً وذات المفاهيم المتباينة) بمجموعها قدمت خطة تامة كاملة للتغيير ، بل ليس أي نوع من التغيير ولكن التغيير الآمن المنضبط بقواعد التخطيط والحكمة العقلانية ، ومن الواضح أن مثل هذا التعميم والادعاء لا يمكن أن يكون صحيحاً وهوغير واقعي أصلاً ، بالذات في ضوء ديناميكية الثورات وكثرة المفاجآت وتعدد الجهات المشاركة فيها.
وفي نفس سياق العامل الأول من عوامل قيام الثورات يقول المؤلف أنه يقدم نفسه كمثال للنجاح في تدوين نظرية كاملة في التغيير من خلال كتاباته كلها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً ، لكن للأسف لم يتحفنا بنصوص وآليات تنفيذ تلك النظرية ، بل يحيل من أراد معرفتها إلى مراجعة كل ما كتب خلال ثلاثة عقود لاستنباط بنودها ومعرفة تفاصيلها ، وهو أمر غريب ولا يثبت ما ذهب إليه المؤلف.
ثم يعدد المؤلف الأسباب الأخرى التي مهدت لاندلاع الثورات ويعزو عدداَ منها لأسباب ترتبط بأعمال وجهود الحركات الإسلامية ، ولا ينسى مشاعر العداء لأميركا بعد عدوانها على العراق وسياساتها في بلادنا ، وكذلك الدور الإعلامي لقناة الجزيرة ، وانتشار الفساد الأخلاقي في الفضائيات والأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية وما شابهها. لكن للأسف مرة أخرى ، فإن الكاتب نظر إلى بعض القضايا بعين واحدة مثل نظره إلى حرب أكتوبر وانتصار مصر على إسرائيل ، وادعائه أنها حرب تحريك لا تحرير ، أو ادعائه على ياسر عرفات بكلام أقل ما يقال فيه أنه بحاجة إلى بينات مؤكدة ، مع أن الواقع ينافي ذلك تماماً.
على أي حال ، ذكر المؤلف الأسباب التي يراها جوهرية ، مع وجود أسباب هامشية أخرى لم يذكرها. لكن من المؤكد من وجهة نظري أن أهم الأسباب الجوهرية للثورات ليس ما ذكر الكاتب وإنما يكمن في ضعف أداء الحكومات وما نشأ عنه من الفقر والتردي الاقتصادي بحيث أصبح من العسير على الشعب المضي أكثر ، فثار بعد أن وصل الأمر إلى لقمة عيشه ورفاه أسرته ، هذا بالإضافة إلى الفساد الإداري والاعتداء على الحريات ، واستفراد مجموعات محددة بخيرات البلاد ، وغياب أفق التغيير ، مع وجود بيئة خارجية محفزة ، وربما مصالح إقليمية ودولية. أقول بأن البعد الاقتصادي كان ولا زال المحرك الأساسي للثورات في بلدان العالم الثالث ، وأكبر دليل على صحة ذلك استقرار الأنظمة في البلدان الغنية في الخليج بالرغم من وجود مجمل الأسباب الأخرى المتعلقة بمبررات اندلاع الثورات المذكورة أعلاه. ليس هذا فحسب ، بل حدثني أحد قيادات الحركة الإسلامية في بلد يفتقر إلى الموارد الكافية ويعيش على المساعدات الخليجية والغربية أن جماعته القوية والقادرة لن تقدم على القيام بثورة ولا حتى أن تدعم قيامها لأنها ترى أن مآل تلك الثورة سيكون إلى الفشل ، وأنه من مصلحة البلد أن يستمر نظام الحكم فيها ضمن الظروف القائمة ، بالرغم من جملة العيوب التي تكتنفه. إذاً هي ليست مدخلات ومخرجات ، بل هي نظرة لما بعد الثورة ، لأن التغيير لا يتم إلا بحساب النتائج والتمكن من الانتقال من حال رديء إلى حال أحسن.
ونادت الملائكة: أن الله أبغض حكامكم فأبغضوهم
تحت هذا العنوان الغريب العجيب يتحدث المؤلف عن نصر الله وتأييده للمؤمنين ، وهذا من الأسباب الأخرى التي لا يعيها من لا يؤمن بالله ، وذلك قول صحيح لأن الله هو القادر وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
ثم يدعي المؤلف أن أسلوب الثورات العربية السلمي الميال إلى الحسم العسكري قد انتقل إلى أمريكا وكندا وكوريا وأوروبا ، ويعزو ذلك ولو جزئياً إلى ما قدمه من مؤلفات تخدم الخلفية الفكرية التي انطلقت منها هذه الثورات. وللأسف ، يبدو أن المؤلف يعيش على كوكب آخر ، لأن العالم لم يسمع بثورات حديثة في الغرب فضلاً عن لجوء الثائرين الغربيين إلى الأسلوب العربي ، والأغرب من ذلك ما يعبر عنه المؤلف بالحسم العسكري المرفوض أصلاً في الغرب الديمقراطي الذي يعترف بتداول السلطة سلمياً وصندوق الاقتراع طريقاً. إن طرح الكاتب لموضوع استخدام السلاح أمر خطير تجاوزته البشرية المتحضرة منذ سنين ، ولا نكاد نجده إلا في الدول الفقيرة والمجتمعات المتخلفة ، وإلا فإن القبول بمنطق الكاتب يعني حلقة مستمرة ودوامة لا تنتهي ممن يمتلك القوة فيسيطر على الحكم بالسلاح لأنه لا يتفق مع أركان الدولة ، وذلك قمة الفوضى والوصفة السحرية للفشل والانحطاط.
ويستطرد المؤلف فيعترف أن نظرية التغيير التي يدعو لها والتي - بحسب قوله - نجحت في تونس ومصر وليبيا وغزة واليمن وسوريا ، لا يمكن أن تنجح في بلده العراق ، ويذكر تفاصيل لا علاقة لها بالموضوع من وجهة نظري. لكن كان الأولى للمؤلف وهو العارف بأحوال بلده العراق أن يقوم بتكييف النظرية (التي لا نعلم عنها شيئاً حتى الآن) كي تنجح في تغيير الوضع العراقي بدلاً من توزيعها والتنظير لها في بلاد العالم بطوله وعرضه. بصراحة لا أجد مبرراً لعنوان هذه الفقرة ومحتواها ، فكلها ليست ذات صلة بالموضوع.
عناوين مرقمة
ينتقل المؤلف في استكمال حديثه من خلال ستة عناوين ، لم يقدم لها بما يربط بين مراده منها ، وإن كان الأرجح (من خلال تفحص مجموعها) أنه يتحدث فيها عن بعض عناصر تنظير التغيير كما يراها وذلك استلالاً من كتاباته السابقة خلال العقود الماضية ، وفي الحقيقة لم أكن بصدد التفصيل فيها ومناقشتها ، وهل يمكن اعتبارها بالفعل مرتكزات أساسية لنظرية التغيير أم لا ، لأن المؤلف أعاد اجترار بعضاً مما كتبه سابقاً إما نصاً أو فلسفة وتفسيراً وقدمه على أنه مادة من تنظير التغيير ، لكن بأسلوب منمق ، وقصص لا تخلو من الحشو الذي يتنافى مع طبيعة الموضوع العلمية. لكن ما دفعني للتعليق لم يكن تلك العناوين وإنما ما جاء في ثنايا بعضها ، مما أعتبره غياب عن الواقع ووصفة للنكبات واستمراراً لحالة الفوضى ، إن لم يكن تأصيلاً لها من شخصية يحترمها أبناء الحركة الإسلامية عموماً (وبديهي أن الأمر لا يعدو اختلافاً في وجهات النظر وليس اتهاماً أو تقليلاً من شأن المؤلف ، بل أعتبره شخصياً مدرسة مميزة في البناء والتحفيز ، والقارئ هو الذي يحكم وله أن يختار) ، وقد جاءت تلك العناوين كما يلي:
1. منطق فقه التغيير
يوضح المؤلف أن أول العلامات التي تميز نظرية التغيير التي يطرحها أن مرجعيتها الإسلام ، بمعنى أن جميع الرؤى والوسائل التي تتضمنها النظرية يجب أن تتوافق مع أحكام الإسلام وضوابطه ، وأن جميع الأعمال السياسية والثورية تقيدها الأوصاف الفقهية الصارمة ، ولا يتم اللجوء إلى المرونة والتيسير إلا في حالات الحرج والضيق ، وذلك لتحقيق مصالح راجحة. إن هذا المنطق يعتبر بديهياً لأي حركة إسلامية ، ولا يمكن لمثل تلك الحركات أن تخالف الشرع وإلا فقدت مصداقيتها ، وعليه فإن هذا الكلام لا يعدو أن يكون تعريفاً بالمعرَّف ، لكن لا بأس من تسطيره. إلا أن تقييد الأعمال السياسية والثورية بالاجتهادات الفقهية الصارمة مع عدم اللجوء إلى المرونة والتيسير إلا اضطراراً ربما احتاج إلى إعادة نظر ، خاصة أن السياسة والثورة قضايا ديناميكية متغيرة ، وتحتاج إلى المرونة والتيسير ، بل والاجتهاد المستمر.
ثم يتطرق المؤلف إلى أن التغيير المنشود يتم بالطرق والأساليب السلمية ، مع تجنب استخدام السلاح وإراقة الدماء ، ويعتبر أن هذا الأسلوب هو المقدم والأساس ، ويسرد العديد من المواقف والنصوص الدينية التي تؤيد مسألة استخدام الأسلوب السلمي والدعوة إلى التغيير بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم يعقب بأن ذلك منوط بالنجاح في عملية التغيير بهذا الأسلوب ، وإلا فإن استبداد الحاكم وظلمه وتنكيله بالإسلاميين يستدعي ويسوغ استخدام القوة لإزاحته عن سدة الحكم ، ويسوق المؤلف بعضاً مما استند إليه فيما ذهب إليه من إجازة استخدام القوة. ويشير المؤلف بداية إلى قول الأستاذ حسن البنا: "والحكومة التي لا ينفع معها النصح والإرشاد ينفع معها القلع والإبعاد" ، وبالرغم من أن النص المذكور ليس قرآناً ولا سنة ، إلا أنه أيضاً لا يحمل في معناه تجويزاً صريحاً لاستخدام القوة ، بل من الممكن أن يكون القلع والإبعاد بشكل سلمي عن طريق الثورة أو التحالفات السياسية. ثم يستطرد المؤلف فيذكر أن استخدام السيف أو القوة لتقويم الحاكم أو استبداله هو مذهب السلف. وفي الحقيقة أرى أن هذه المسألة والاختلافات الواردة فيها ليست ذات بال في بناء نظرية التغيير في هذا الزمان ، إذ دعونا نسلم أن استخدام السلاح مبرر شرعاً ، ولا غبار عليه في الفقه ، لكنني أجزم أن ذلك غير ممكن من الناحية العملية والواقعية في هذا الزمان ، كما هو واضح من التوصيف أدناه.
إن التغيير بالسيف والسلاح يستدعي كفاية القوة عدداً ونوعاً ، كما يقول المؤلف ، فهل يعقل أن تحوز الجماعات والأحزاب السياسية وقوى التغيير المجتمعية الأسلحة الآلية والدبابات والطائرات ، كتلك التي تحوزها الدولة بمقدار ترجح الفراسة معه ظن النجاح ، كما يشترط المؤلف؟ وهل توجد دولة أو حكومة عاقلة تسمح لمواطنيها بامتلاك السلاح وحيازته بأنواعه بغرض استخدامه ضدها مستقبلاً؟ ثم من الذي سيحدد إن كان الحاكم مستبداً بدرجة تقتضي استخدام السلاح؟ وماذا لو كانت بعض الأحزاب والقوى السياسية ترى في الحاكم صلاحاً أو أن الظرف الدولي أو الإقليمي يفرض عليه التصرف بطريقة ما ، بينما خالف ذلك وجهة نظر الإسلاميين ، فهل سيثور الإسلاميون على الدولة والقوى المؤيدة لها ، وقد تكون قوى إسلامية ، سلفية أو دعوية أو غيرها؟
أرى أن الصحيح أن نعترف ونقر أن بعض أعلام الفقه الإسلامي يجيزون استخدام القوة ، إذ ليس من المنطق أن يتم الحكم بغير ما أنزل الله في دولة إسلامية ، لكن ليس معنى ذلك أن تتبنى الحركة الإسلامية في منهجيتها هذا الأسلوب في بيئة مغايرة تماماً لتلك التي عاشها المسلمون في العصور الماضية. إن اعتماد منطق استخدام القوة في أدبيات الحركة الإسلامية يعتبر من أهم عوامل ضعفها ، والسبب الرئيسي في الابتلاءات والمحن التي تعرضت لها ، وعجزها عن تكوين التحالفات السياسية ، وحشرها في الزاوية غارقة في الاتهامات ، وفي موضع الدفاع عن النفس. ومن جهة أخرى ، على مر تاريخ الحركة الإسلامية هل استفادت الحركة من تضمين مفهومها في استخدام القوة لتحقيق التغيير السياسي المنشود؟ الجواب على هذا السؤال الهام هو النفي ، بل العكس هو الصحيح. ولننظر إلى بدايات محنة الإخوان في مصر ألم تكن بسبب السلاح؟ ، وكذلك ما حدث في سوريا ومرة أخرى فيما حدث مع الجماعة الإسلامية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وما حدث مع تنظيم الدولة في عدة مناطق في العالم وغيرها. أما حماس التي احتج بها المؤلف في موضع آخر فلم تراكم القوة من أجل إزاحة حاكم ظالم ، وإنما لإزاحة محتل غاشم ، وإنما حصل الإشكال بينها وبين فتح وللطرفين جيشين منظمين تنازعا الحكم والسيطرة وتغلب أحدهما على الآخر. بمعنى آخر ، لقد خسرت الحركة الإسلامية كثيراً ميدانياً وشعبياً ولا زالت تدفع الأثمان السياسية لعدم إقرارها بخطئها في اعتماد مبدأ استخدام السلاح بناء على الآراء الفقهية (التي لا ننكرها). إن أول طريق الإصلاح يتضمن إعادة بناء منهجية التغيير بعيداً عن استخدام السلاح ، مع الإقرار والسعي لتجريم ذلك في مجتمعاتنا ، وإعلان الحركة الإسلامية صراحة عن ذلك ، بل وتسليم أية أسلحة لديها إلى الجهات المختصة كبادرة حسن نية ، عندها تكون الحركة قد انتقلت نقلة نوعية ودخلت عالم التغيير من أوسع أبوابه ، وفي نصوص الشرع البديهية والأساسية ما يؤيد توجهها وما ذهبت إليه ، وستلتف حول دعوتها الجموع.
بالطبع ، أنا أعلم أن البعض لن يعجبه تأويلي ، وأعتبر أن هذا حقه ما لم يعتد على حقوق الآخرين ، لكن دعونا نقلب الصورة لنكتشف أهمية استبعاد استخدام السلاح في مجتمعاتنا المعاصرة. لننظر إلى حالة مصر بعد فوز الحركة الإسلامية وانتخاب الرئيس مرسي رحمه الله حيث رأت جماعات متنوعة بما فيها الجيش أن حكم الإخوان لا يناسب ظروف مصر ولن يحقق طموحاتها (أو أنه يهدد مصالحهم المباشرة) ، فاستخدم الجيش القوة العسكرية ونجح في الإطاحة بالرئيس مرسي وبحكم الإخوان المسلمين ، والسؤال: ماذا لو كانت لدى الإخوان قوة كافية نوعاً وكماً (مع استحالة ذلك) فإلى أين كان من الممكن أن تصل الأمور ومستقبل الدولة؟ وعلى العكس من ذلك ماذا لو عمل الإخوان طيلة السنوات الماضية على بناء ثقافة تداول السلطة ، والتقارب مع الجماعات والأحزاب المؤثرة ، وبناء التحالفات السياسية على أساس مصلحة الدولة والمواطنين ، وتجريم استخدام السلاح ضد المواطنين أو لتحقيق أهداف سياسية ، وتحييد الجيش عن التدخل في السياسة ، هل كان من المرجح أن تصل الحركة الإسلامية في مصر إلى ما وصلت إليه اليوم؟ وبعيداً عن ذلك لنسأل سؤالاً بسيطاً: في الدولة الإسلامية التي يحكمها إمام ورأت بعض الجماعات أنه ظالم أو أنه مستبد فهل من حقها الإعداد للثورة المسلحة وشراء وتخزين الأسلحة الموازية لأسلحة الدولة ، وتشييد مراكز التدريب السرية ، تمهيداً للانقضاض على أركان الدولة إن لم ينفع معها النصح والإرشاد؟ هل يرى عاقل أن هذا الأمر منطقي أو واقعي؟
ثم يختم المؤلف هذا العنوان فينقد نفسه عند قوله أن الجمال سينقذ العالم ، والجمال المقصود هو كل أنواع الجمال بما في ذلك جمال الحرية والصدق والعدل والأخلاق وغيرها ، وليس فقط جمال العمارة والبناء ، والسؤال ، إذا كان الجمال يمكن أن ينقذ العالم فلماذا اللجوء إلى السلاح؟. لكن يجدر هنا التنويه أن الجمال كصورة لا يمكن أن ينقذ العالم ولكن على حركات الإصلاح توضيح أهمية وفوائد الجمال ، وتزيين صورته كي يشعر بها العامة والمثقفين وأصحاب الرأي فيحبونها ، وبالتالي يكونون من دعاتها والمطالبين بها ، فيحدث التغيير.
2. ظاهرة الشباب الضاغط
يذكر الكاتب أن تراكمات الثورة الفكرية المعاصرة (يقصد مجموعة المؤلفات التي قام أعلام الحركة الإسلامية بإصدارها خلال العقود الماضية) وما أسهم فيها المؤلف بما يعرف بكتب إحياء فقه الدعوة ومن تضمنته من شروحات واجتهادات ، كانت الوقود الذي أشعل ثورات الربيع العربي ، ولا ينكر عاقل اسهامات المؤلف في التنظير لأهمية وضرورة التزام الدعاة بأحكام وتعاليم وأخلاق الإسلام ، وأن ذلك مدعاة لرضا الله عز وجل والفوز بجنته ، وفي ذات الوقت يعتبر توطئة للتغيير ومدخلاً للحكم الصالح. وأزيد بأن أسلوب المؤلف كان لافتاً وموفقاً وبارعاً في اختيار وصياغة عباراته بالذات في كتبه الأكثر رواجاً من المنطلق والعوائق والرقائق ، فقد أحسن المؤلف ونال قبولاً وافراً لما ورد فيها من معان وبلاغة وإتقان.
إلا أن المعاني التي حاول المؤلف نسبتها إلى إبداع مؤلفاته في التنبيه إليها لم تكن في نظري جديدة على الفكر الإسلامي والإخواني. فمثلاً من المعروف أن الإخوان لا يؤيدون الانقلابات العسكرية ، ولا حتى الثورات كما جاء في أقوال الأستاذ حسن البنا ، الذي لاحظت أن المؤلف في أكثر من موضع ينزل كلامه منزلة المسلم به من الفقه ، وإن لم يتفق معه فإنه يأوله ويفسره بطريقة قد لا تكون مقبولة من وجهة نظري ، والأصح في تقديري أن ينقد ما يراه شاذاً أو لا يتوافق مع الواقع ، لأن الإقرار بعدم عصمة البنا وأي قائد آخر يعتبر جزءاً من التربية. أما أهمية الشباب وإقدامهم وتضحيتهم فقديم قدم الدعوة ، ففي الحديث "نصرت بالشباب" ، ولا ننسى تولية الشاب أسامة على رأس جيش فيه كبار الصحابة. ولا شك أن دور الشباب في عملية التغيير يعتبر حجر زاوية في النجاح ، لكن من خلال خبرتي فإنني أختلف مع المؤلف في تصدير بعض الشباب للقيادة واتخاذ القرار ، لأني أرى أن هذا مدعاة للفتنة ، ويتماشى مع رغبة جامحة ومطالبات للشباب بتولي القيادة ، مع اتهامات للحكماء والشيوخ بعدم فهم الواقع وعجزهم عن تحقيق الطموحات والنجاحات ، فيتولى قليل الخبرة ، وينشغل بأعمال القيادة وهمومها ويذوب في مشاكلها ، دون أن يأخذ حظاً وافراً من العلم والخبرة والتدريب ، فتكون المصيبة ، لكن لا بأس أن يقتربوا من القيادة دون ممارستها أو يمارسون بعضها تحت رقابة ، والله أعلم.
ثم ينتقل الكاتب إلى معلم آخر من معالم التغيير ، فيذكر أن الدعاة قيدوا أنفسهم بلزوم ما لا يلزم ، وذلك بظنهم – حسب قوله – بضرورة وجود أعداد كافية من الأفراد الذين استوعبوا الفكرة وتقدموا بالبيعة لقادة الحركة ، ويذكر المؤلف أن ذلك ضرب من الخيال ، إذ لا يمكن أن يحدث ، لما للالتزام وشروط البيعة من ضوابط وقيود لا يستطيعها إلا القليل ، لأن الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة. لذلك يستطرد المؤلف بالقول أن الحركة الإسلامية يجب ألا تقتصر على العدد المحدود من أبنائها الذين نالوا حظاً وافراً من التربية والفهم والالتزام ، ذلك لأن هذا العدد مهما بلغ لن يكون كافياً لعملية التغيير كما قدم الكاتب ، وعليه يقترح المؤلف اعتماد مبدأ الولاء للحركة في تقدير قوتها ، بدلاً من اعتماد الأعداد القليلة التي بايعت قيادتها وتدين لها بالسمع والطاعة. لكن هل يرى القارئ فيما تقدم أي جديد ، فقد كان ولا يزال مبدأ الولاء والمؤيدين لفكرة معينة موجوداً على مر العصور قديمها وحديثها ، بل قام رسولنا الكريم بتجهيز جيش لقتال قريش لأنها نقضت عهدها وقتلت رجالاً من قبيلة خزاعة وهم في عقده وعهده الموالين له ، لذلك أقول أن طرح موضوع الولاء لا يضيف أي جديد قدمه المؤلف ليجعل منه قاعدة سماها الولاء بدل الطاعة والبيعة ، فكل الأحزاب والحركات لها قاعدتها الصلبة ولها أيضاً من يؤيدها دون أن يكون عضواً فيها ، والولاء يقتضي النصرة.
ثم يوضح المؤلف ما أورده في أصول الإفتاء والاجتهاد من أن خطة العمل السياسي والجهادي يلزمها أن تتوسع وتكون أكثر مرونة وواقعية لتشمل الاستعانة بأبناء الأمة الذين شغلت ذممهم الدينية ببعض الهفوات الفسوقية والأخلاقية ، وهذا لا يخالف أو يزيد على ما أوردناه من استبدال أو تكامل البيعة مع الولاء ، وقد وصف المؤلف هذه الفئة في مواضع مختلفة من كتابه بالأرباع والأنصاف والأثلاث. إلا أن معضلة الحركة الإسلامية في هذا التوصيف أو الإستعانة أكبر من أن تجبر ، لأنها أباحت لنفسها الاستعانة بمثل هؤلاء أشخاصاً وأحزاباً ، لكنها لا تريد لهم المشاركة بالقيادة والسيطرة ، بل عند النجاح في الوصول إلى الحكم لا تكون الحكومة إلا لها وبالأخص لقاعدتها الصلبة في القيادة ، مما يؤشر على أن مبدأ المشاركة كما تفهمه الحركة الإسلامية يتمثل في استغلال مشاركة الموالين لها وغيرهم في مساندتها وحملها كي تتوسد سدة الحكم ، وهو مفهوم مرفوض ولن يوصل الحركة إلى أي مكان متقدم ، وإن وصلت سرعان ما تعود القهقرى ، لأن الشراكة والمشاركة عامة شاملة. إن قناعة الحركة الإسلامية ومنها المؤلف أن لها الأحقية الطبيعية والمطلقة في قيادة عملية التغيير أو الثورة ومن ثم الحكم تعتبر حجر عثرة في مشروع التغيير ، وعلى الحركة أن تعلن في أدبياتها وتحالفاتها أن نهاية المطاف في عملية التغيير أو الثورة الوصول إلى عملية انتخابية نزيهة ، تتيح للشعب اختيار قيادته وأسلوب حياته ، أما ما عدا ذلك فستبقى الحركة في دائرة الشك والاستبعاد.
وللأسف يكرر المؤلف في أكثر من موضع أن الحركة الإسلامية بنواتها الصلبة وقيادتها المركزية قادت التغيير بنجاح ، وهو كلام مردود بحكم الواقع ، بل الأهم من ذلك وبعد فشل جميع ثورات الربيع العربي تبين أن الحركة الإسلامية ومعها الأحزاب والحركات السياسية والمجتمعية تفتقر إلى خطط التغيير ، وكانت بعيدة عن الواقع ومنفصلة تماماً عن البيئة التي تعيش فيها. ولعلي أعود إلى الوراء لأذكر ما دار في لقائي مع أحد قيادات الحركة الإسلامية والذي كان في زيارة للرئيس مرسي رحمه الله قبل الانقلاب بأيام قليلة ، وقد سألته كيف يرى الرئيس مرسي والإخوان الاحتجاجات ضده ، وما هي درجة تأثيرها وخطورتها على حكم الإخوان؟ فأجابني أن الوضع مطمئن ولا ترى الجماعة أي خطر من تلك المعارضة ، بل على العكس تماماً.
بعد ذلك يناقش المؤلف – وأتفق معه – أنه لا بد من وجود قيادة منظمة للثورة ، تراقب حركتها وتوجهها وتحرص على عدم انجرارها للعنف والقتال أو التخريب ، وهذا بالطبع لا يتأتى في وجود تيار غير منظم أو عفوي ، وإن كنت أرى أن التيار من الممكن أن ينجح في حالة الثورة الخاطفة ، إلا أن مخاطر مصادرة الثورة وانتكاسها تكون كبيرة في مثل هذه الحالة.
أخيراً يتحدث المؤلف عن ضرورة التنمية الشاملة في الانتاج والتصنيع والعلوم والحد من البطالة ، إضافة إلى وجود مشروع حضاري ، مع الاهتمام بإجادة التخصصات المختلفة ، والتربية الإيجابية في جميع مناحي الحياة. إلا أن معظم تلك النشاطات يمكن أن تكون مطلوبة ومهمة لما بعد الثورة وليس مدخلاً لها ، لأن التخطيط وامتلاك كل ذلك منوط بإمكانات هائلة لا تستطيعها إلا الدولة ، وتحقيقها ربما يحتاج إلى أجيال ، بينما يمكن للحركات والجماعات توجيه ثلة من أفرادها لامتلاك المهارات والتخصصات المنوعة ، وتركيز جهودها في التربية والتقويم وتحقيق النجاحات الأخلاقية.
3. شروط تجريبية وظواهر إيجابية
تحت هذا العنوان يعود الكاتب ليؤكد مرة أخرى أن تحقيق الأهداف لا يمكن أن يتم عبر جهود الدعاة (النواة الصلبة) وحدهم ، وإنما أيضاً جهود الأصدقاء والمتعاونين والحلفاء ، إضافة إلى نجاح الحركة في تحييد بعض الفئات ، وبالرغم من أن هذا أمر طبيعي إلا أن المؤلف يستخدمه لسرد ما يقول أنها بنود عديدة في نظرية التغيير ، أجملها بما يلي:
أولاً: في مجتمع من ملايين يكفي تحريك عشرات الألوف للقيام بثورة ناجحة!!!.
ثانياً: وجوب التشدد في معايير الجرح والتعديل عند انتقاء أعضاء التنظيم الخلفي وقادته.
ثالثاً: التربية الدينية الأخلاقية للدعاة والموالين لهم ، لأن الإعداد والتخطيط لا يكفي بل يحتاج من الله مدد.
رابعاً: التخطيط للتغيير جزء من نظريته.
خامساً: الاهتمام بالإعلام.
سادساً: المشاركة النسوية.
بعد ذلك يتحدث الكاتب عن أهمية العمل الجماعي والتفكير المشترك ، ويشبه الحوار والنقاش الجماعي بالسوبركمبيوتر ، وللحقيقة ليس واضحاً لي مراد الكاتب ، إذ أن العمل الجماعي والشورى مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة ، ولا يمكن أن يعتبر المؤلف نفسه أنه اهتدى لما عجز عن الاهتداء إليه آخرون ، فيدعي أنه اهتدى إلى استحضار عبقرية خارقة وليس مجرد ذكاء!!! ، وكأن الكاتب يخاطب قراء من غير هذا العالم.
ويعود المؤلف ليثبت تناقضاً جديداً عندما يدعي أن الثورة المصرية لم تنجح بسبب ذلك المتظاهر الذي يحمل الحاسوب ويبث الصور ومقاطع الفيديو (كما هو مقرر في تنظير التغيير الذي قدمه الكاتب والذي يعتبر الإعلام الرقمي حجر زاوية فيه) ، ولكن لأن خطة اللواء طنطاوي التقت مع رغبات ذلك الشاب "فأراد أن يتغدى بمبارك قبل ان يتعشى به" ، بينما يعتبر المؤلف أن النشاط التنظيمي التراكمي الذي قدمته الدعوة كان "السبب الثاني" في النجاح!!!.
وفي نفس السياق يقول المؤلف أن ما عند الإخوان من تربية علمية وإيمانية ترفعهم عند الاختلاف عن السلوك التنافسي المعيب ، وأن الإخوان تحكمهم آداب الخلاف وفقهه ، ومنها الابتعاد عن تجريح الأفراد والهيئات والمؤسسات ، ويلتزمون قول البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. لكن للأسف ، هذا لم يمنع الكاتب نفسه من كيل التهم والتجريح لشخصيات محترمة ، تبوأت أعلى المناصب القيادية ، حتى من الإسلاميين من أمثال عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا وكمال الهلباوي ، بسبب اجتهادات يمكن استيعابها ، وكذلك ما طال حزب النور من انتقادات لاذعة على لسان المؤلف ، ويمكن مراجعة كتابه الردة عن الحرية لمعرفة المزيد.
ويستطرد المؤلف فيذكر ضرورة الاستفادة من الغوغاء (عامة الناس) في الضغط والتأثير ، ويجب الاستعانة بهم دون منحهم القيادة والصدارة ، لأن سلسلة المنافع لا تكتمل بدونهم. وللأسف أرى أن التعبير قد خان المؤلف هذه المرة أيضاً ، فألحق بهذه الفئة أوصافاً دونية لا تليق ، ومن ذلك قوله أن على الرؤساء التعامل معهم بحسب "قيمتهم" ، وأنه لا يليق أن تحويهم صفوف الدعاة ، وأن على الحركة أن تقترب منهم ، وأن يجمع الدعاة شظايا الخير فيهم مهما كانوا فساقاً في القياس الشرعي ومهما كانوا أصحاب نقص فطري وقلة ذكاء وضعف في القدرات!!!. بالفعل كلام غريب ، ولذلك قد تحتاج الحركة إلى دائرة خاصة تقوم بتصنيف الناس فهؤلاء أنصاف وأرباع وأخماس وأسداس ، وأولئك من الغوغاء ، وفئة ثالثة من الموالين ، ورابعة وخامسة كذا وكذا!!!.
وبعد إعادة تأكيد الكاتب على أهمية الإعلام ، يعود ليكرر ضرورة تكوين جيل من علماء الشريعة القادرين على الاجتهاد والاستنباط ، ويختم هذا العنوان بالحديث عن الأزمة العراقية ومؤامرات أمريكا ، والدور الإيراني وحزب الله في العراق وسوريا ، وضرورة التأكد من استبعاد نظرية التغيير لأي دور لهما (يقصد إيران وحزب الله).
4. حركة الحياة تغيير
أهم ما يقدمه المؤلف تحت هذا العنوان يمكن أن يكون تقديمه لمعيار "الحرية أولاً" ، لأن ديدن الحركة الإسلامية التركيز على أن الإسلام أولاً ، وهي جدلية فكرية تتعلق بإيهما نبدأ ، والصحيح أن الحرية تقود إلى اختيار الإسلام والمطالبة بتطبيق أحكامه ، وأن المطالبة بالحرية تشترك فيها جميع قوى التغيير ، مما يوجد الأرضية المشتركة للتعاون ، ويختصر الطريق إلى زوال الأنظمة الفاسدة ، خاصة مع إقرارنا أن تغيير المنظومة الحاكمة وتطبيق الإسلام هو خيار شعبي يعتمد على الحرية. لكن على الجانب الآخر ، هناك عدد وافر من أبناء الحركة الإسلامية تبنوا هذا الرأي في فلسفة التغيير ، وهو ليس بالأمر الجديد ، لكن أن يأتي ذلك على لسان المؤلف يعتبر أمراً غاية في الأهمية من وجهة نظري. ثم يذهب الكاتب إلى أبعد من مجرد تبني شعار الحرية أولاً إلي مطالبته بتهيئة الظروف والأدوات والتربية الكفيلة بترسيخ مفاهيم الحرية حتى يعشقها الشعب ، وبالتالي يزداد حرصه عليها ومطالبته بها.
كذلك أشار الكاتب إلى أهمية اكتساب الدعاة للخبرة في استخدام وسائل التواصل والانترنت ، لأنها لغة العصر ، ولضرورة إزالة الحواجز بينهم وبين الشباب الذي تربى في بيئة الحاسوب والانترنت ، وبديهي أن ذلك مطلوب وطبيعي للغاية.
5. المعجزة الشبابية
يبدأ المؤلف بالتساؤل خاصة بعد هذا العمر الطويل للحركة الإسلامية دون تحقيق التمكين ، وعدم قدرتها على تجاوز كونها نخبة في تركيبتها التنظيمية: هل القلة المؤمنة مؤهلة للإصلاح والتغيير ، وإلى متى تستمر الحركة في دعوة الناس دون نتيجة تذكر؟.
ويجيب المؤلف على تساؤله من واقع ما ورد من قصة موسى مع قومه ، ويخلص إلى ضرورة الاستمرار في المحاولة والسعي إلى التغيير ، فإن لم يستجب قوم ربما استجابت ذريتهم في المستقبل ، مع إيلاء أهمية كبرى لدور جيل الشباب في عملية التغيير.
بعدها يتحدث المؤلف عن التجربة التركية ، ويحاول تفسير لماذا نجح الخيار السلمي المحض فيها ، ثم يستنتج أن الدعاة في سائر البلاد الإسلامية عليهم اتباع الأسلوب السلمي لأنه الأصل ، وأن استعمال القوة استثناء توجبه الضرورة فقط. وهنا لا يزال المؤلف واقعاً تحت سطوة وسيطرة القناعة بإمكانية استخدام القوة في عملية التغيير ، وأتمنى أن يراجع فكره في هذه القضية لأن مجرد امتلاك القوة (فضلاً عن استخدامها) يعني كتابة شهادة وفاة للتنظيم والحركة التغييرية ، لأن العاقل لا يختار الساحة والسلاح التي يتفوق فيهما خصمه ، هذا بالإضافة إلى أن الواضح أن عمليات التغيير السلمي ممكنة ، وأن عدم النجاح ناشئ عن بعض الأخطاء ، أو أن الإعداد والتهيئة لم تكن كافية.
ويبدو المؤلف معجباً ومؤيداً لعملية التغيير على الطريقة التركية ، التي يقول أنها أضافت ثلاثة إضافات لنظرية التغيير ، وذلك من خلال نموذج قوي من الخدمات المدنية والتنموية ، ورفعها لشعار الحرية أولاً ، إضافة إلى الحد الأدنى من مراعاة مصالح أميركا. لكنه يعود ليذكر بعض أخطاء أردوغان ، ومنها ما يعتبره أكبر سقطاته عندما ذهب إلى خطأ حماس في قرارها رفض الصلح الدائم وعدم اعترافها بإسرائيل التي هي حقيقة واقعة حسب قوله. لكن هل أردوغان الوحيد الذي يقول بذلك؟ بالطبع هذا يتوقف على فهمنا للسياسة وطبيعتها الديناميكية ، حيث أن الثابت الوحيد فيها أنه ليس فيها ثوابت ، وأن موازين القوى على الأرض هي التي ترسم الحدود. وللعلم ، فإنه في أحد المؤتمرات الدعوية التي عقدت في أمريكا وحضرها عدد من كبار قادة الحركة الإسلامية ، فقد أفتى مجتهد من قيادات الحركة الإسلامية المصرية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي خلال نقاش موضوع جواز الاعتراف بإسرائيل ، حيث قرر أن ذلك جائز شرعاً ، وأن التوقيع على العقد لا يعني شيئاً لما فيه من الإكراه ، وأن المسألة كلها سياسية في أصلها. أما الخطأ الثاني من وجهة نظره فتمثل في وساطته بين أميركا والفصائل الجهادية العراقية لإنهاء القتال والانضمام إلى الحكومة ، وعدم انحيازه للمقاومة. وهذا أيضاً مردود عليه بأن تركيا تمارس دور إقليمي من خلال الوساطات ، ويجب أن يكون واضحاً أن كل طرف (وليس الوسيط) هو الذي يحدد مصالحه ، والمدى الذي يمكن أن يذهب إليه. إضافة إلى أخطاء أخرى من وجهة نظر المؤلف ، لكن أعتقد أن أردوغان – وإن لم يكن منزهاً عن الأخطاء – كان ينفذ السياسة التي تتوافق مع مصالح بلاده ، وأنه في العديد من القضايا غير سياسته أو عدلها لتستجيب لتلك المصالح ، كما لا يمكن لأحد أن يتوقع أو يعلم يقيناً انعكاس المواقف المغايرة على تركيا ، فيما لو تم اعتمادها.
أنتقل الآن إلى بعض المفاهيم التي بسطها المؤلف فس كتب أخرى ، وذلك لما لها من علاقة وطيدة بفلسفة التغيير.
التخطيط الاستراتيجي مقابل الخبرة التنظيمية
لا شك أن القارئ لكتاب رؤى تخطيطية سوف يستغرب كيف يمكن لتنظيم كبير الحيود عن مبادئ ومقتضيات التخطيط الاستراتيجي ، بذريعة الخبرة المتراكمة التي تولدت لدى عناصر التنظيم المنشغلين في الدعوة منذ عقود. ذلك لأن أولئك الدعاة لا بد وأن يكونوا أسهموا في بناء الخطط الاستراتيجية ، وشاركوا في صياغتها ، وقدموا كل ما يملكون من خبرات لإنجازها في أبهى صورة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تشعب قضايا التخطيط الاستراتيجي وعدم حصرها في زاوية واحدة أو زوايا قليلة قد يكون أحد الدعاة بارعاً فيها ، لكن المؤكد أنه لن يكون متمكناً من جميع أصولها وفروعها وترتيبها الزمني وأدواتها المطلوبة وغير ذلك مما يعلمه المشتغلون في هذا المجال. جاء في كتاب رؤى تخطيطية ما يلي: وأما الدعاة فهم أصحاب قضية مشتركة ، وتطورت العاطفة عندهم إلى عقيدة ، ولهم امتداد تاريخي ومكاني ، فصارت الحصيلة الخاصة (يقصد الترسبات التجريبية) شطراً موازياً مساوياً لعلم التخطيط العام ، ولهم أن يرفلوا بمفاد المعاناة التي خضعوا لها فإنها يقين ، والوصايا الواردة في الكتب ظن وتخمين. ثم يقرر الكاتب أن الموظف الحكومي هو الذي ينصح بالتقيد بالوصايا التخطيطية العالمية ، وكأن الموظف الحكومي ليست لديه أضعاف تلك الترسبات التجريبية - التي حازها الدعاة - نتيجة القضايا اليومية التي يعاركها طوال عمله في وظيفته!!!.
إن هذا المنطق في تقديم الخبرة (التي من الممكن لكثيرين ادعائها في المجال الدعوي تحديداً) على مكانة التخطيط الاستراتيجي ، والإيحاء باختيارية التزام الدعاة بالوصايا التخطيطية يعتبر أمراً خطيراً ، ولا شك أن الحركات الإسلامية التي تتبنى هذا الفهم غير المنضبط والذي لا يمكن متابعته ، أو محاسبة من يتبناه يعتبر خرقاً لقواعد أصول الإدارة ، ويساوي التخبط والفوضى.
ثم يعيد الكاتب تأكيد رؤيته في تقديم الخبرة على التخطيط فيقول: ونحن (يقصد الحركة الإسلامية) نحترم الحقيقة التخطيطية ، ونذعن للمرئي من حياة الشعوب والجماعات وحركات الجيوش والساسة من ضرورة السيطرة على ساحة العمل ومعطياتها ، واعتماد خطة واضحة الأركان قبل التقدم ، ولكن الأثر القيادي عندنا نراه أنفذ من التخطيط وأبعد في التحكم والتغيير. ويتابع بما هو أعجب فيقول: ويزداد هامش هذا التأثير إذا اكتسبت القيادة شحنة عاطفية يراها التابعون صورة من صور الإلهام والتوفيق الرباني الذي تحمله الملائكة لكل مؤمن يتفانى ويخلص من أجل رفعة أولياء الرحمن في الحياة الدنيا. إذاً ليس فقط تقديم الخبرة ، ولكن أيضاً الإلهام والتوفيق الرباني ، والسؤال: الخبرة قد يمكن تحديدها بشكل أو بآخر ، إلا أن الإلهام والتوفيق الرباني أمر لا يمكن قياسه لتحديد درجته ، لأن كل مؤمن لديه درجة أو صورة ما منه ، لكن أن يتم تقديم كل ذلك على النهج التخطيطي فإن ذلك يعني باختصار وضع القرار كاملاً في يد القيادة ، حيث الطبيعي أن لا ينازعها أحد في الخبرة والدراية والإلهام والفتح الرباني ، وعلى التخطيط السلام.
ويؤكد الكاتب استنتاجاته وقناعاته حيث يقول: نحن جماعة مؤمنين ارتضوا مؤمناً منهم يجتهد وهم حوله رقباء ومساعدون. ولذلك يكون الأداء القيادي أبعد أثراً من التخطيط في محيطنا ، وهذه ظاهرة في الحياة الدعوية تترجح فيها الإرادة القيادية على الالتزامات التخطيطية بشكل تلقائي غير متكلف ، وهذه التلقائية في منح القيادة نقطة امتياز على السلطة التخطيطية هي جزء من تلقائية أوسع تظهر في المحيط الدعوي. وكأننا في عصر الوحي وصدر الإسلام وعلى بعد مئات السنين مما شهده التطور الإداري والتخطيطي ، حتى يتم تقديم رأي الواحد أياً كان على رأي الجماعة ، لأن التخطيط عمل جماعي ويمكن النظر إليه على أنه شكل من أشكال الشورى ، خاصة وأن عدداً كبيراً من القيادات شاركت في صياغته ، ولم يتم اعتماد مخرجاته دون أخذ آراء الجهات القيادية العليا بعين الاعتبار. باختصار ، فهم مغلوط وخطير لمنزلة التخطيط ، وذلك أقصر طريق للفشل.
اتخاذ القرار
في كتاب الاستنباط الاستراتيجي يقر المؤلف بصعوبة التعامل مع مجموعات كبيرة من المعلومات والحقائق ، وبالتالي صعوبة تحويلها إلى جملة قرارات دون اللجوء إلى أسلوب علمي رصين لجمع الحقائق المتناثرة وربطها وجعلها في معادلات ، ونحن بذلك بحاجة إلى إطار نظري لا بد من استعارته من علم الاستراتيجيات والإدارة لاختيار القرار الأمثل ، بما في ذلك استخدام الرياضيات لقياس المزايا الصافية للبدائل والوصول إلى قيمة واحدة لكل بديل ، يكون القرار قد اتخذ ضمنياً ، ويصبح الاختيار عملية بسيطة تافهة.
ولعلي أشير هنا إلى أن الكاتب بحديثه عن صعوبة الوصول إلى قرارات صحيحة في وجود كم هائل من المعلومات قد أصاب كبد الحقيقة. لكن أجدني مضطراً إلى بعض التفصيل لتوضيح المسألة ، حيث أصبح معلوماً أن اتخاذ القرار غالباً ما يكون سهلاً ويحتاج إلى جهد بسيط في بعض الأحيان ، ولكن المشكلة ليست في اتخاذ القرار في وجود معلومات وتناقضات ، وإنما في صناعة القرار ، لأن صناعته هي في الحقيقة عملية متكاملة تتطلب الجهد والوقت واللجوء إلى النظريات الرياضية الملائمة ، وعندما يتم تقييم البدائل كخطوة من خطوات صناعة القرار ، تكون آخر خطوة وثمرة تلك الصناعة اتخاذ القرار ، الذي بالفعل يصبح واضحاً واتجاهه معلوماً ، وإلا نكون بحاجة إلى إعادة التقييم باستخدام أدوات إضافية.
وحيث أن أي قرار يحتوي على مخاطرة ، فإن الكاتب يشير في فقرة أخرى إلى ذلك بقوله: والاستراتيجيون يحاولون اصلاح عيب عدم المخاطرة بإضافة عامل المعايير التي تصف الواقع والخيارات بأحكام أكثر تفصيلاً ، (يقول الكاتب) هكذا أفهم المعايير. وهي تقييد للمبدع فيما أرى ، وأرى أنه لا حدود لهذه المعايير ، وإنما هي قضية استنباطية وتكون على درجات من الأهمية. ويتابع بقوله: وهكذا تكون عوامل اتخاذ القرار ثلاثة: درجة السيحان واستقطاب الأهداف أثناء البحث وتحكيم المعايير الموضوعية ، وبالنسبة للمسلم تقوم جميع الكتلة الإيمانية والشرعية والتفسيرية للقرآن الكريم كقاعدة تحتية للمعاييرالموضوعية التي يقيس بها ، وإذا أخلى ذهنه من هدف وانتظره أثناء البحث ، وهي عملية نفسية سهلة: فإن فن اتخاذ القرار عنده سينحصر في الاستعداد لالتقاط الصواب من خلال التأمل الحر السائح وانتظار ومضات الإبداع واستعراض الصور الوصفية لأجزاء الحياة ودرجات نبضاتها ، وتكون كل القصة أسهل عليه من تعقيدات الاستراتيجيين ، وذلك الذي أريده لدعاة الإسلام حين وضعت لهم نظرية حركة الحياة.
أما تعقيبي على ذلك ، فإنني أشير إلى أن الاستراتيجيين الذين أفتوا بضرورة صناعة القرارات وعدم الركون إلى الخبرة أو التفكر والتأمل الحر فقط ، أولئك بنوا فلسفتهم على أن بيئة القرار تحوي عدداً من الأهداف وعدداً آخر من البدائل ، وقد يتطلب الأمر أن يستجيب القرار لعدد من المعايير (ليس بالضرورة طبعاً أن تكون شرعية) ، وعليه فإن موضوع المفاضلة بين البدائل يتطلب عرض كل منها على مجموعة كبيرة من المتغيرات في نفس الوقت ، وهو ما لا يحسنه العقل البشري ، ويحتاج إلى حاسوب. ففي علم الرياضيات من المعروف أننا بحاجة لعدد معادلات يساوي عدد المتغيرات المراد حساب قيمتها ، ورياضياً أيضاً من غير المفيد محاولة حل ثلاث معادلات كل منها تحتوي على ثلاث متغيرات يدوياً لأن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً ، والأفضل استخدام حاسوب فما بالنا بعشر معادلات وعشر متغيرات مثلاً؟. لذلك عندما نتحدث عن عملية صناعة القرار وما فيها من متغيرات كثيرة ، فإن استخدام التأمل الحر أو انتظار ومضات الإبداع لن تكون لها قيمة ، ولا يمكن استخدامها إلا في القرارات البسيطة (التي لا تحتاج إلى صناعة) من أمثال نوعية القصص التي يعرضها الداعية في ندوة معينة ، أو ماذا يلبس الداعية عند إلقائه خطبة الجمعة ، أو هل يذهب الداعية إلى المسجد ماشياً أو راكباً. لكن قراراً من قبيل هل تشارك الحركة في الانتخابات أم لا؟ أو هل تدخل الحركة الانتخابات منفردة أم ضمن ائتلاف؟ هل تقوم الحركة بإنشاء نادي رياضي أم مستشفى؟ وغير ذلك مما يستدعي صناعة قرار يستجيب لمصالح الحركة بشكل أفضل. إذاً ، القضية لا تتعلق بتربية او خبرة أو إلهام مقابل تعقيدات الاستراتيجيين او ضرورة الدخول في عملية صعبة ، وإنما هي طبيعة الأشياء ولزوم ما يلزم ليس إلا.
الرؤى والإلهام
في كتاب صناعة الحياة يشير الكاتب أن ظاهرة السيطرة المستقبلية ، وخلاصتها أن الله تعالى قد أذن لبعض خلقه أن يعلم بعض العلامات والقرائن الدالة على ما سيحدث في المستقبل من غير جزم ، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ، ولكن بنوع من الترجيح يقذف طمأنينة في قلب المؤمن ، فيتصرف تصرفاً هادفاً متناسباً مع ما يتوقعه من الأحداث ، فيسيطر بذلك لا على يومه فقط وإنما على المستقبل أيضاً.
وأستغرب لماذا يسرد الكاتب هذا الكلام ، فإن كان بغرض تشجيع سائر المؤمنين على اتباع قلوبهم وهداية ربهم التي يعرفونها بعلاماتها وعايشوها سابقاً ، فهذا أمر لا يحتاج إلى تذكير ، لأنها طبيعة الأشياء ، وكل إنسان أدرى بما يصلح شأنه (من وجهة نظره على الأقل). لكن طبيعي أن تندمل في ثنايا هذا الكلام مشكلة كبيرة إن قصد الكاتب من كلامه هذا تغليب الإلهام على التخطيط ، ونزوع الجماعة إلى اعتماد تلك الالهامات (!!!) لاتخاذ القرارات في الشأن العام.
وللأسف ، فقد أوضح المؤلف رأيه في ذلك فقال: الرؤيا الصالحة والإلهام جزء من قراءة المستقبل ، وللمؤمن أن يركن إلى بعض ما يراه ، وللمؤمنين وأمرائهم أن يركنوا إلى رؤيا أخ لهم معروف بصدق الرؤيا إذا أخبرهم أنه رأى علامة صدقها ، فيفعلون أمراً متناسباً مع مفاد الرؤيا ، أو يمتنعون عن فعل نووه مما هو داخل في نطاق التخطيط والمواقف والقرارات.
وتعقيباً على ذلك أقول أنه بالفعل هناك إلهامات أو رؤى يراها بعض الناس وتأتي كفلق الصبح ، وأرى أن على الشخص المعني أن يتبعها فإنها علامة وآية خاصة به ، إنما لا يسع الجماعة اعتماد تلك الالهامات والرؤى إن خالفت التخطيط وأساليب الإدارة الحديثة. وقد تواردت أخبار وروايات كثيرة لقيادات وأفراد من هؤلاء الذين يدعون الالهام والرؤى الصادقة (وأعتقد شخصياً أنهم لامسوها أكثر من مرة) لكن عندما تم اعتمادها كمصدر للحقيقة لم تكن صادقة مطلقاً. ومن ذلك ما يعرفه البعض من الشك بل واتهام بعض الأفراد بالعمالة للمحتل وتعريضهم لأشد أنواع التعذيب وربما القتل ، بناء رؤيا تبين أنها من شيطان رجيم ، لا من رحمن رحيم. خلاصة القول ، العمل الجماعي تحكمه قوانين وأنظمة وخطط استراتيجية ومرحلية ، ومن الخطر الشديد في الفهم والتطبيق الحديث عن الرؤى والإلهامات كأسس للتحرك واتخاذ القرارات ، لكن على المستوى الفردي فكل إنسان أدرى بنفسه ، وليس بينه وبين الله ترجمان ولا وسيط.
في الختام ، أعتقد أن الخلاف في بعض القضايا الجزئية لا يفسد للود قضية ، خاصة عندما يكون ذلك في الأمور السياسية الاجتهادية ، وإن كنت أرى الكثير من المعاني الإيجابية التي وردت في كتب المؤلف المختلفة ، بالذات كتب التربية الإسلامية والأخلاق والتحفيز ، وأعترف بفضل الكاتب في تقديم سرديته فيها بأسلوب مبتكر ومميز ، وكنت سأسعد كثيراً في مناقشته فيما كتبت عوضاً عن النشر ، ولكنها أمانة الكلمة وما فرضته تعقيدات الحياة خاصة علينا في فلسطين.
لكن بلا شك تفتقر بعض تلك الكتب التي تناقش السياسة والتغيير والاستراتيجيات والإدارة والعمل العام إلى من يسبر غمارها ، ويجمع ما تناثر في ثنياتها من قضايا محددة لتأصيلها أو وضعها ضمن النظريات الحديثة ، وبما ينسجم مع التطور الفكري والإداري ، أو ينقدها ويصحح مفاهيمها ، بالنقاش الهادئ والدليل المنطقي والعقلي والتجريبي ما أمكن.
إن بناء وصياغة نظرية التغيير بفرضياتها وقوانينها وبنودها وقيودها وخطتها العامة ممكن ، ولا شك أن بعضاً منه تناثر في الكتب المختلفة للمؤلف وغيره ، ومن المتوقع أن يسهم في تطور الفكر الإسلامي كثيراً من خلال إجابته على مجمل التساؤلات المتعلقة بعملية التغيير ، آخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية ، وتطور الفكر الإسلامي ، والكفاءة المستمدة من الدراسات العلمية ذات الصلة ، ونظريات التغيير المنشورة على الشبكة العنكبوتية.
أ.د. منذر سليم عبد اللطيف
monzir394@gmail.com
أعدت تصفح بعض كتب المؤلف والمفكر الإسلامي البارز ، المعروف في أوساط الإسلاميين الأستاذ محمد أحمد الراشد ، والذي أكن له كل احترام وتقدير. وعلى رأس تلك الكتب كتاب تنظير التغيير ، الدافع الرئيسي لكتابة السطور أدناه ، حيث سأتناول بعض ما جاء فيه من مفاهيم أختلف معه فيها. وكذلك ما لفت انتباهي من قضايا فكرية واجتهادية أرى أنها لا زالت مشوشة ومضطربة في الفهم التقليدي للإسلام الحركي ، والتي لا أجد حرجاً في التعبير عن أختلافي مع الكاتب في تفاصيلها ، ولا أخفي أنني بذلت كثيراً من الوقت والجهد في محاولة نقدها منذ عقود. أيضاً ، سوف أقوم بالتعقيب ونقد بعضاً مما ورد في كتابات أخرى للمؤلف ، بالذات تلك المفاهيم المتعلقة بفلسفة التغيير والتي أراها مقلقة وليست في محلها ، ولا بد من إعادة النظر فيها ، إذا أرادت الحركة السير قدماً ، والتخلص من بعض الأوهام التي تآلفت معها عبر السنين ، والخروج من الحلقة المفرغة التي لا زالت تتخبط فيها منذ نشأتها.
وأبدأ بكتاب تنظير التغيير ، حيث تم تقديم الكتاب على أنه يمثل النظرية التكاملية للتغيير السياسي الإسلامي ، وحيث أنني مهتم بدراسة فلسفة التغيير فقد قرأت الكتاب بتمعن ، واطلعت على نظرة الكاتب وطريقة معالجته لهذا الموضوع ، الذي كان ولا زال يمثل في رأيي نقطة أساسية من نقاط ضعف الفكر التعبوي النظري والعملي للحركة الإسلامية ، وكان ولا يزال – من وجهة نظري – من أبرز مسببات الاشتباك السلبي سواء مع الأنظمة الرسمية أو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الأخرى.
وللأسف الشديد ، فبدلاً من توضيح الفكرة وبسط عناصرها ومناقشة مفاهيمها وترتيب صياغاتها فإنني لم أجد سوى مجموعة من الأطروحات الهلامية المتشابكة التي غلب عليها الأسلوب الإنشائي والجمل التصويرية التي يتميز بها أسلوبه الكتابي ، وقد رأيت أنها تحوي في ثناياها بعضاً من التناقضات وغاب عنها التحديد والوضوح الذي كان الأولى في مثل تلك الدراسات العلمية الهامة ، لأن الموضوع من المفروض أنه لا يتعلق بالحماسة وشحذ الهمم بقدر ما يعالج التأصيل ومخاطبة العقل وقوة المنطق ، بالذات عند الحديث عن فلسفة التغيير أو مرتكزات التنظير للتغيير السياسي الإسلامي ، بما ينسجم مع الفكر الإسلامي في أجواء الحداثة والواقع.
لكن من المؤكد أنني استمتعت بقراءة العديد من مؤلفات السيد الراشد ، وما يأتي به من الصياغات الأدبية المميزة ، والأشعار الرائعة التي يسوقها بين ثنيات موضوعاتها ، ولا يمكن لمنصف أن يقلل من شأن وتأثير تلك الكتابات في موضوعات التربية وتقويم السلوك ، وشحذ الهمم ، وبث الحماسة والتفاؤل والتدين ، لكن هذا لا يعني القبول والتسليم بكل ما يورده ، إذ لا أحد معصوم في المسائل الاجتهادية ، بالذات في موضوع يتعلق بالمصلحة العامة والفكر السياسي والتغيير.
يبدأ الكاتب عرضه بمقدمة غريبة أعتقد أنها تلخص ما جاء في الكتاب من تلاطم أفكار تفتقر إلى التسلسل المنطقي والتركيز المعرفي ، فيذكر في صفحته الأولى أن موضوع الكتاب بمجمله كان عبارة عن محاضرة طويلة خاطب فيها عشرات من قيادات الدعوة ، واستغرقت ساعات عديدة ، وذلك بعد سقوط حكمي مبارك وبن علي ، ويشير أنه قد تم تصوير المحاضرة بشكل تقني عالي المستوى ، إلا أنها ضاعت!!!. وهنا استوقفتني أمور عدة ، منها:
أن الكاتب أراد لهذه المحاضرة أن تشيع بين العرب والعجم لأهميتها بحسب قوله ، وهذا تقدير مقبول من الكاتب إذ يمكن تبريره على المستوى الشخصي نظراً لشعوره بأهميتها ، لكن ليس مفهوماً كيف يمكن لمثل هذه المحاضرة الفيصلية والهامة أن تضيع ، بالرغم من أن المتحدث والحضور من أكبر قيادات الحركة الإسلامية ، وإذا لم تتمكن تلك القيادات من المحافظة على تسجيلات محاضرة واحدة فهل من الممكن أن يدعي الكاتب أو غيره التنظير للتغيير؟ وقد يستغرب القارئ من موضوع ضياع المحاضرة ، إلا أن ذلك يذكرني بحديث جرى بيني وبين أحد قيادات الحركة الإسلامية ، كان يدلل فيه على مدى العناية الربانية بالحركة ، ويذكر أنه أثناء سفره جواً إلى كندا في ثمانينيات القرن الماضي وبعد وصول الطائرة تبين له وصول جميع متاعه إلا حقيبة واحدة لم تظهر ، وللأسف فقد كانت تلك الحقيبة تحوي كامل معلومات التنظيم في بلده. وبعد طول انتظار في صالة الحقائب لم يجد بداً من التقدم بإفادة فقد حقيبة ومن ثم مغادرة المطار ، ليكتشف بعد أيام وقوعها في يد موظف صومالي الأصل يعرف العربية ، فحافظ عليها وأعادها كاملة سالمة إلى ذلك القيادي. وأردف يحدثني عن قيادي آخر من بلده تم اقتياده فجأة من الشارع إلى فرع المخابرات ومعه حقيبة فيها أسماء وعناوين جميع أعضاء التنظيم في مدينته ، في الوقت الذي كان الانتساب فيها للحركة يعني "الإعدام" في حينه ، وتعرض للتحقيق والاستجواب إلا أنهم لم يطلبوا منه فتح الحقيبة ولم يفتشوها ، لحسن الحظ!!! ، وإلا كانت حلت كارثة لا يعلم مداها إلا الله. فهل معنى ذلك أن التغيير المنشود يراد له أن يعتمد على الحظ ، وبالرغم من أنه ممكن أحياناً ، إلا أن ذلك ليس من طبيعة الأمور. وفي الواقع ، كنت أتمنى أن أعلم كيف تم معالجة أمر فقدان المحاضرة ، لأطمئن إلى استحداث الحركة الإسلامية آليات مناسبة تقودها إلى تغيير النمط.
أيضاً ، يذكر الكاتب في ذات السياق أنه أصيب بالذهول شهوراً بعد معرفته بضياع المحاضرة ، فأضرب عن الكلام حتى شفع شافعون ، فكتب الكتاب الذي نناقشه. ويستطيع القارئ عند مطالعة مقدمة الكاتب التخمين أنه كان يرتجل الكلام في موضوع التغيير ارتجالاً لساعات ، ولم تكن لديه نسخة ورقية فاستعاض عن كل ذلك بكتابة الكتاب ، وهو أمر لا يليق بكاتب أو منظر كبير يتحدث عن موضوع عظيم أن يرتجل بهذه الطريقة ، لدرجة أن يتملكه الحزن على ضياع التسجيل لاحتوائه على أجواء المحاضرة وما تخللها من حماسة (لا يتطلبها التنظير للتغيير في حضور قيادات العمل الإسلامي). ثم يعبر الكاتب عن سبب حزنه بأنه لا يقبل افتعال الحماسة التي تملكته عند إلقائه المحاضرة أول مرة إذا ما قام بإعادة تسجيل المحاضرة. وهو أمر غريب ، لأن الداعية قد يقوم بإلقاء محاضرة في مكان ، ثم يعود ويلقيها في مكان آخر لمجموعة ثانية وثالثة ، فتزداد المحاضرة عمقاً ويزداد المحاضر إلماماً وتمكناً ، وليس فيه تزوير ولا غيره إن كان بعيداً عن التنمق والتكلف ، وفي رأيي أن تلك الأوصاف التي ساقها الكاتب للتعبير عن غضبه وحزنه كانت متكلفة أكثر من اللازم ، ولم يكن لها ضرورة ، أو أنها انعكاس لطبيعة الكاتب العاطفية الجياشة (كما أظن). أيضاً أرى أنه من غير المبرر استخدام أساليب الحماسة وارتفاع الصوت والضرب على المنضدة (كما ذكر الكاتب) في وجود قيادات ، وليس مجموعة من الأفراد العاديين ، فالقيادة تحتاج إلى الحديث بروية وإعمال العقل والتفكير للوصول إلى نتائج ، بعكس الرعاع والأتباع من الصفوف الدنيا الذين تحركهم العواطف ويحتاجون إلى الخطاب الحماسي. كل ذلك يؤشر إلى عدم الروية والتمعن في الاستنتاجات التي سيسردها الكاتب في الفصول المبعثرة ، حيث يفتقر الكتاب إلى الفهرس المناسب ، مما أضفى عليه طابع التشتت والتفكك والفوضى.
ويتابع الكاتب في نهاية الصفحة الأولى فيقول بأن نجاح الثورات في مصر وتونس وليبيا أوجب صياغة نظرية التغيير لتكون هادية لثورات أخرى ولثورات يجب أن تقوم في كل بلاد العرب وإيران والكثير من بلاد المسلمين!!!. وهنا لا بد من تسجيل بعض النقاط التي أعتبرها جوهرية في الخطاب الإعلامي والسياسي للإسلاميين. أول تلك النقاط أنه ليس من المنطق ولا المعقول إظهار الشماتة في الأموات من الساسة الذين سقط حكمهم ، بالذات إذا لم تتم إدانتهم في محاكم عادلة ، لأنهم خصوم سياسيون ليس إلا. وأرى أنه ليس من الإنصاف ولا المروءة الحديث عن أحدهم أنه لجأ إلى نفق المجاري أو أنه أظهر الجبن ، أو وصف حاكم اليمن أنه جاهل اليمن وغيرها ، فهذه الأوصاف لا علاقة لها بالموضوع ولا تقدم أية إضافة ، بل تستثير عداوة أنصاره ومؤيديه وقبيلته ، وتجعل من التحالفات السياسية أكثر صعوبة ، وتثير الشك والريبة في الإسلاميين ومستقبل حكمهم ، فضلاً عما قدمه بعض هؤلاء من دعم ورعاية للعديد من قضايا الأمة. ومن الممكن استحضار قصة حقيقية توضح ما حدث نتيجة سوء تقدير لجهاز أمن حركة إسلامية كبيرة في التعامل مع أحد أعيان إحدى العائلات ، حيث قامت الحركة بامتهان كرامته والاعتداء عليه داخل ديوان (مقر) عائلته ، مما اعتبرته العائلة إعتداء عليها ، فلم تخسر الحركة خيرة شبابها من أبناء تلك العائلة فقط ، بل ناصبوها العداء.
كما أن الدعوة إلى قيام الثورات في كل البلاد العربية وغيرها يعتبر من وجهة نظري سذاجة مفرطة وخطأ لا يغتفر ، إذ من المعروف أن لكل قطر ظروفه الخاصة ، وما ينسحب على بلد معين ليس بالضرورة أن ينسحب على بلد أو بلاد أخرى ، والأهم من ذلك أن مثل هذا الكلام قد يحسم أمر الكثير من الأنظمة في عداوتها للحركة الإسلامية ، إذ تشكل مثل هذه الدعوات (التي لا تسمن ولا تغني من جوع) ذريعة مبكرة للعمل ضد تلك الحركات دون فائدة تذكر ، بعد أن كشف الكاتب نياتها ، وصرح أن قادتها ينتظرون الفرصة ويتربصون بالبلاد للنيل من حكوماتها وأنظمتها ، وليس من الواضح إن قصد الكاتب شيئاً آخر.
كما يستطرد الكاتب بالدعوة إلى الاستعجال وأخذ زمام المبادرة قبل أن تستثمر تلك الظروف الناضجة مجموعات ساذجة ليس لها فقه ثوري. ويدعو المؤلف المجموعات الدعوية إلى أخذ زمام المبادرة وفق خطط ونظرية مؤصلة شرعاً ومنطقاً ، وعلى خلفية تجريبية وافرة ، وتعليلات فلسفية من علم الحياة!!!. وفي تلك الدعوات أفخاخ وافتراضات لا أساس لها من الصحة. فبدلاً من دعوة المؤلف إلى التعاون وبناء أرضيات مشتركة مع قوى التغيير المختلفة ، فإنه يصرح بتوجسه وخوفه منها ، ودعوته إلى تصدر المشهد ، بأي ثمن ، خوفاً من سذاجة تلك القوى أو تحسباً لوقوع الحركة الإسلامية أو الثورة ضحية الانتهازية ، وهذا بحد ذاته مغاير لحركة الحياة القائمة على التعاون للوصول إلى الحقوق المشتركة. ثم أين هي الخلفية التجريبية الوافرة لدى الإسلاميين في الثورة ، وأين هي الصورة الواقعية التي توضح طريقتهم وفلسفتهم في الحكم؟ للأسف ، مجرد الفاظ وكلام لا منطق فيه ، وهو دعوة للقضاء على ما تبقى من مصداقية للحركة الإسلامية ويضر بها أكثر من كيد أعدائها ، وما هو إلا ترجمة حرفية للفكر المشوش للتغيير في عقلية الحركات الإسلامية ، إن صح التعبير.
ثم يعبر المؤلف عن إيمانه وقناعته التامة أن النصر والتمكين للجيل الإسلامي الحاضر حاصل لا محالة بالرغم مما يعتري هذا الجيل من نواقص وخلل في مواطن كثيرة ، إذ يكفي أن تكون هناك فئة قليلة من الدعاة الأنقياء المخلصين حتى يتحقق التمكين. وأرى أن هذا القول أيضاً لا يصح ، فالتغيير هو سنة كونية (كما يشير المؤلف في موضع لاحق) ، وسواء كان هناك مخلصين أم لم يوجد ، فالمجتمعات تشيخ ويحدث التغيير بشكل طبيعي أو بالثورة. لكن أخشى ما أخشاه أن يكون المؤلف يقصد أن تتولى تلك الفئة المخلصة القليلة والنقية الحكم في البلاد ، أو أن التغيير في وجودها يقتضي تصديرها بشكل طبيعي للحكم ، وفي هذا الفهم خلل لا يمكن التسامح معه. وحتى في المنهج الإسلامي المعتبر ، فإن الشورى أو الانتخاب يعتبر المسوغ الأساسي للحكم في الأوضاع العادية الأقرب إلى مجتمعاتنا الحالية ، وليس شرطاً بالطبع أن يتم اختيار المخلصين الأنقياء. والسؤال: إذا حصل التغيير وسقط الطغاة ، وفي نفس الوقت لم يحكم المخلص النقي فهل يعتبر المؤلف أن التغيير الحاصل إيجابي أم أنه بحاجة إلى تغيير؟
إن الدعوة إلى التغيير ليست مقتصرة على فئة من المجتمع دون أخرى ، وبديهي أن الإسلاميين ساهموا في تكوين ثقافة التغيير ، لكنهم لم يكونوا الوحيدين. وعلى الحركة الإسلامية بداية الاعتراف أنها جزء من حركة المجتمع وليست كل المجتمع ، بل لها شركاء بالرغم من أنهم ناصبوها العداء الفكري ، واختصموا معها في مواطن وأزمنة كثيرة ، ولا يقتنعون بقدراتها ولا نياتها ، لكنهم أثروا الساحة بأفكارهم ودعواتهم إلى التغيير ، ولديهم مؤسسات قوية قائمة ، وليس هناك مناص من البحث عن القواسم والأهداف المشتركة ، وسبل التعاون مع تلك القوى ، للوصول إلى تلك الأهداف التي تحقق المصلحة العامة. كما يجب الاعتراف أن الله خلق الناس مختلفين ، وبعد أن أصبحت هناك قناعة لدى الإسلاميين بتداول السلطة والاحتكام إلى صندوق الاقتراع ، فقد أصبح من السهل التعاون مع الجميع ، وعليه فإن القاعدة الذهبية التي يجب أن تعيها الحركة الإسلامية تقول بأن الحركة لا يمكن أن تدعي أحقية الحكم منفردة بحجة أنها حركة إسلامية تحتكر الصواب وتمتلك الحقيقة المطلقة ، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن مجرد التسليم بمبدأ الحق في تداول السلطة وأن الشعب هو المفوض الوحيد للسلطات (وليس صلاح الفرد أو انتماؤه إلى الحركة الإسلامية) ، والدفاع عن هذا المبدأ يعتبر حجر زاوية في فهم دور الحركات الإسلامية في التغيير ، كما يفتح الباب على مصراعيه للتحالفات السياسية ، بما يختصر الطريق نحو الحرية المنشودة ، والشعب هو الذي يختار ، واختياراته تُحترم.
ولعل الكاتب يشير إلى بعض تلك المعاني فيقول أنه لو حرص الدعاة المخلصون على التعاون والتكامل مع أرباع وأنصاف حملة المعاني الإيجابية من تعاليم الإسلام لكان الوصول إلى الحرية أسرع بكثير ، بل يذهب المؤلف إلى شرعنة التدرج في الوصول إلى الحكم الإسلامي ، وبين أن ذلك يمر بتوفير الحريات العامة والحقوق السياسية وتشجيع المواهب والنهوض الصناعي ، ثم يكون من بعد ذلك إعلان تطبيق الشريعة والأحكام!!!. وبالرغم من البدايات المشجعة للمؤلف حول ضرورة الاهتمام بمناحي الحياة المختلفة التي تضمن الحريات والكرامة والتقدم ، إلا أنه يختم ذلك بإعلان تطبيق الشريعة والأحكام ، وهو أمر لا مفر من اعتماده من الشعب إما بالاستفتاء أو بانتخاب أغلبية ساحقة من الحركة الإسلامية ، وعليه يعتبر هذا الموضوع تحصيل حاصل في تلك الأحوال ، وإن مجرد سوقه هنا يدعو إلى الريبة. والسؤال: ماذا لو فازت الحركة الإسلامية بالأغلبية وأعلنت عن تطبيق الأحكام الشرعية ، ثم بعدها بسنوات قليلة خسرت الانتخابات وتم إلغاء تطبيق الشريعة ، فما هو موقف الحركة الإسلامية حينها؟ إن موضوع تطبيق الشريعة ليس موضوعاً ذا مغزى في بلادنا الإسلامية أصلاً ، والتي تطبق فيها معظم الشرائع الإسلامية ، لكن المتمعن في الموضوع قد يستنتج أن الموضوع سياسي في أصله ، لكنه يرتدي اللباس الديني ، ربما لأسباب سياسية ، حيث أقر الكاتب بإمكانية تأجيل وتدرج تطبيق الشريعة. إن فهم الحركة الإسلامية للشريعة وتطبيقاتها في الحياة يجب أن يكون أكثر انفتاحاً واتساعاً ، ويجب ألا يبقى مصطلح تطبيق الشريعة من المصطلحات الفضفاضة ، بل يجب تحديد القضايا الشرعية بدقة ، وما كان خاضعاً للحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الخاصة أن يتم إدراجه تحت هذا البند ، وما كان خاضعاً للمخدرات أو الخمر أن يندرج تحته ، وهكذا ، مع دراسة كل تلك الأمور بانفتاح ومرونة بما لا يمس أصول وجوهر الدين ، ومن الممكن استخدام التحالفات السياسية لتحقيق الكثير من القضايا المتناثرة التي تعتبر جزءاً من الشريعة.
إن اعتراف المؤلف بأهمية التدرج والعمل على إنجاز العديد من الأمور الخاصة بالحكم الرشيد هو أمر جيد ، لكن استنتاجه أن نهاية المطاف تقتضي الإعلان عن تطبيق الشريعة يوحي أن هناك ضبابية واضحة وخلط بين المقدمات والنهايات ، لأن المقدمات تعتبر من أعمال الحركات والأحزاب السياسية ، أما الإعلان عن تطبيق الشريعة فهو أمر آخر يقتضي موافقة العامة والمؤسسات المختصة ، وهو أمر لا تقضي به الحركة الإسلامية ، حتى لو وصلت إلى الحكم بطريقة شرعية.
بعد ذلك يقر المؤلف أن التكوين والتعبئة الثورية شارك فيها الإسلاميون والعلمانيون وكثير من الأحرار غير المنتمين من سائر المشارب والتخصصات ، كلهم أسهموا في بناء الشخصية الثورية ، وهي شهادة محترمة ، يتبعها كم من الحواشي والأمثلة التي لا تمت بصلة لنظرية التغيير السياسي. لكن لعل الأهم من ذلك الإجابة على التساؤل: ما دام شارك الجميع في بناء الشخصية الثورية واسهموا في تهيئة الأرضية المناسبة للثورة ، فهل المنطق أن تنفرد جهة دون غيرها في الحكم ، ومن الذي يقرر طبيعة الحكم والحاكمين؟ من المؤكد أن يسهم الجميع في الحكم كل بحسب حجمه والتفويض الذي يمنحه له الناخبون ، وأن مطالبة جهة معينة بالانفراد في الحكم يعتبر خيانة للمجموع ، ومحاولة لمصادرة جهودهم وغمطهم حقهم وإسهاماتهم.
عوامل التصعيد التي أدت إلى الثورات
يذكر المؤلف تسعة من العوامل يعتبر أنها الأكثر تأثيراً في اندلاع الثورات ، ويدعي أن الدعوة الإسلامية بكل جماعاتها قدمت من خلال مفكريها "نظرية تامة كاملة للتغيير الآمن المنضبط بقواعد التخطيط والحكمة العقلانية" وهو كلام غريب ولا رصيد له على الإطلاق من وجهة نظري ، إذ لم يعدُ ما تم تقديمه مجموعة من الوعظيات والتذكير بأمجاد السلف مختلطاً بالكثير من قصص العدل والبطولة ، لكن الإنصاف يقتضي الإقرار أن معظم المشاركين سواء في الثورة المصرية أو التونسية لم يكونوا أصلاً من التيار الإسلامي ، وحتى أبناء الحركة الإسلامية لم تكن لديهم وليس لديهم إلى اليوم ما يمكن أن يطلق عليه خطة جاهزة للتغيير ، فكيف يدعي المؤلف أن الجماعات الإسلامية (المختلفة والمتناحرة أصلاً وذات المفاهيم المتباينة) بمجموعها قدمت خطة تامة كاملة للتغيير ، بل ليس أي نوع من التغيير ولكن التغيير الآمن المنضبط بقواعد التخطيط والحكمة العقلانية ، ومن الواضح أن مثل هذا التعميم والادعاء لا يمكن أن يكون صحيحاً وهوغير واقعي أصلاً ، بالذات في ضوء ديناميكية الثورات وكثرة المفاجآت وتعدد الجهات المشاركة فيها.
وفي نفس سياق العامل الأول من عوامل قيام الثورات يقول المؤلف أنه يقدم نفسه كمثال للنجاح في تدوين نظرية كاملة في التغيير من خلال كتاباته كلها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً ، لكن للأسف لم يتحفنا بنصوص وآليات تنفيذ تلك النظرية ، بل يحيل من أراد معرفتها إلى مراجعة كل ما كتب خلال ثلاثة عقود لاستنباط بنودها ومعرفة تفاصيلها ، وهو أمر غريب ولا يثبت ما ذهب إليه المؤلف.
ثم يعدد المؤلف الأسباب الأخرى التي مهدت لاندلاع الثورات ويعزو عدداَ منها لأسباب ترتبط بأعمال وجهود الحركات الإسلامية ، ولا ينسى مشاعر العداء لأميركا بعد عدوانها على العراق وسياساتها في بلادنا ، وكذلك الدور الإعلامي لقناة الجزيرة ، وانتشار الفساد الأخلاقي في الفضائيات والأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية وما شابهها. لكن للأسف مرة أخرى ، فإن الكاتب نظر إلى بعض القضايا بعين واحدة مثل نظره إلى حرب أكتوبر وانتصار مصر على إسرائيل ، وادعائه أنها حرب تحريك لا تحرير ، أو ادعائه على ياسر عرفات بكلام أقل ما يقال فيه أنه بحاجة إلى بينات مؤكدة ، مع أن الواقع ينافي ذلك تماماً.
على أي حال ، ذكر المؤلف الأسباب التي يراها جوهرية ، مع وجود أسباب هامشية أخرى لم يذكرها. لكن من المؤكد من وجهة نظري أن أهم الأسباب الجوهرية للثورات ليس ما ذكر الكاتب وإنما يكمن في ضعف أداء الحكومات وما نشأ عنه من الفقر والتردي الاقتصادي بحيث أصبح من العسير على الشعب المضي أكثر ، فثار بعد أن وصل الأمر إلى لقمة عيشه ورفاه أسرته ، هذا بالإضافة إلى الفساد الإداري والاعتداء على الحريات ، واستفراد مجموعات محددة بخيرات البلاد ، وغياب أفق التغيير ، مع وجود بيئة خارجية محفزة ، وربما مصالح إقليمية ودولية. أقول بأن البعد الاقتصادي كان ولا زال المحرك الأساسي للثورات في بلدان العالم الثالث ، وأكبر دليل على صحة ذلك استقرار الأنظمة في البلدان الغنية في الخليج بالرغم من وجود مجمل الأسباب الأخرى المتعلقة بمبررات اندلاع الثورات المذكورة أعلاه. ليس هذا فحسب ، بل حدثني أحد قيادات الحركة الإسلامية في بلد يفتقر إلى الموارد الكافية ويعيش على المساعدات الخليجية والغربية أن جماعته القوية والقادرة لن تقدم على القيام بثورة ولا حتى أن تدعم قيامها لأنها ترى أن مآل تلك الثورة سيكون إلى الفشل ، وأنه من مصلحة البلد أن يستمر نظام الحكم فيها ضمن الظروف القائمة ، بالرغم من جملة العيوب التي تكتنفه. إذاً هي ليست مدخلات ومخرجات ، بل هي نظرة لما بعد الثورة ، لأن التغيير لا يتم إلا بحساب النتائج والتمكن من الانتقال من حال رديء إلى حال أحسن.
ونادت الملائكة: أن الله أبغض حكامكم فأبغضوهم
تحت هذا العنوان الغريب العجيب يتحدث المؤلف عن نصر الله وتأييده للمؤمنين ، وهذا من الأسباب الأخرى التي لا يعيها من لا يؤمن بالله ، وذلك قول صحيح لأن الله هو القادر وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
ثم يدعي المؤلف أن أسلوب الثورات العربية السلمي الميال إلى الحسم العسكري قد انتقل إلى أمريكا وكندا وكوريا وأوروبا ، ويعزو ذلك ولو جزئياً إلى ما قدمه من مؤلفات تخدم الخلفية الفكرية التي انطلقت منها هذه الثورات. وللأسف ، يبدو أن المؤلف يعيش على كوكب آخر ، لأن العالم لم يسمع بثورات حديثة في الغرب فضلاً عن لجوء الثائرين الغربيين إلى الأسلوب العربي ، والأغرب من ذلك ما يعبر عنه المؤلف بالحسم العسكري المرفوض أصلاً في الغرب الديمقراطي الذي يعترف بتداول السلطة سلمياً وصندوق الاقتراع طريقاً. إن طرح الكاتب لموضوع استخدام السلاح أمر خطير تجاوزته البشرية المتحضرة منذ سنين ، ولا نكاد نجده إلا في الدول الفقيرة والمجتمعات المتخلفة ، وإلا فإن القبول بمنطق الكاتب يعني حلقة مستمرة ودوامة لا تنتهي ممن يمتلك القوة فيسيطر على الحكم بالسلاح لأنه لا يتفق مع أركان الدولة ، وذلك قمة الفوضى والوصفة السحرية للفشل والانحطاط.
ويستطرد المؤلف فيعترف أن نظرية التغيير التي يدعو لها والتي - بحسب قوله - نجحت في تونس ومصر وليبيا وغزة واليمن وسوريا ، لا يمكن أن تنجح في بلده العراق ، ويذكر تفاصيل لا علاقة لها بالموضوع من وجهة نظري. لكن كان الأولى للمؤلف وهو العارف بأحوال بلده العراق أن يقوم بتكييف النظرية (التي لا نعلم عنها شيئاً حتى الآن) كي تنجح في تغيير الوضع العراقي بدلاً من توزيعها والتنظير لها في بلاد العالم بطوله وعرضه. بصراحة لا أجد مبرراً لعنوان هذه الفقرة ومحتواها ، فكلها ليست ذات صلة بالموضوع.
عناوين مرقمة
ينتقل المؤلف في استكمال حديثه من خلال ستة عناوين ، لم يقدم لها بما يربط بين مراده منها ، وإن كان الأرجح (من خلال تفحص مجموعها) أنه يتحدث فيها عن بعض عناصر تنظير التغيير كما يراها وذلك استلالاً من كتاباته السابقة خلال العقود الماضية ، وفي الحقيقة لم أكن بصدد التفصيل فيها ومناقشتها ، وهل يمكن اعتبارها بالفعل مرتكزات أساسية لنظرية التغيير أم لا ، لأن المؤلف أعاد اجترار بعضاً مما كتبه سابقاً إما نصاً أو فلسفة وتفسيراً وقدمه على أنه مادة من تنظير التغيير ، لكن بأسلوب منمق ، وقصص لا تخلو من الحشو الذي يتنافى مع طبيعة الموضوع العلمية. لكن ما دفعني للتعليق لم يكن تلك العناوين وإنما ما جاء في ثنايا بعضها ، مما أعتبره غياب عن الواقع ووصفة للنكبات واستمراراً لحالة الفوضى ، إن لم يكن تأصيلاً لها من شخصية يحترمها أبناء الحركة الإسلامية عموماً (وبديهي أن الأمر لا يعدو اختلافاً في وجهات النظر وليس اتهاماً أو تقليلاً من شأن المؤلف ، بل أعتبره شخصياً مدرسة مميزة في البناء والتحفيز ، والقارئ هو الذي يحكم وله أن يختار) ، وقد جاءت تلك العناوين كما يلي:
1. منطق فقه التغيير
يوضح المؤلف أن أول العلامات التي تميز نظرية التغيير التي يطرحها أن مرجعيتها الإسلام ، بمعنى أن جميع الرؤى والوسائل التي تتضمنها النظرية يجب أن تتوافق مع أحكام الإسلام وضوابطه ، وأن جميع الأعمال السياسية والثورية تقيدها الأوصاف الفقهية الصارمة ، ولا يتم اللجوء إلى المرونة والتيسير إلا في حالات الحرج والضيق ، وذلك لتحقيق مصالح راجحة. إن هذا المنطق يعتبر بديهياً لأي حركة إسلامية ، ولا يمكن لمثل تلك الحركات أن تخالف الشرع وإلا فقدت مصداقيتها ، وعليه فإن هذا الكلام لا يعدو أن يكون تعريفاً بالمعرَّف ، لكن لا بأس من تسطيره. إلا أن تقييد الأعمال السياسية والثورية بالاجتهادات الفقهية الصارمة مع عدم اللجوء إلى المرونة والتيسير إلا اضطراراً ربما احتاج إلى إعادة نظر ، خاصة أن السياسة والثورة قضايا ديناميكية متغيرة ، وتحتاج إلى المرونة والتيسير ، بل والاجتهاد المستمر.
ثم يتطرق المؤلف إلى أن التغيير المنشود يتم بالطرق والأساليب السلمية ، مع تجنب استخدام السلاح وإراقة الدماء ، ويعتبر أن هذا الأسلوب هو المقدم والأساس ، ويسرد العديد من المواقف والنصوص الدينية التي تؤيد مسألة استخدام الأسلوب السلمي والدعوة إلى التغيير بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم يعقب بأن ذلك منوط بالنجاح في عملية التغيير بهذا الأسلوب ، وإلا فإن استبداد الحاكم وظلمه وتنكيله بالإسلاميين يستدعي ويسوغ استخدام القوة لإزاحته عن سدة الحكم ، ويسوق المؤلف بعضاً مما استند إليه فيما ذهب إليه من إجازة استخدام القوة. ويشير المؤلف بداية إلى قول الأستاذ حسن البنا: "والحكومة التي لا ينفع معها النصح والإرشاد ينفع معها القلع والإبعاد" ، وبالرغم من أن النص المذكور ليس قرآناً ولا سنة ، إلا أنه أيضاً لا يحمل في معناه تجويزاً صريحاً لاستخدام القوة ، بل من الممكن أن يكون القلع والإبعاد بشكل سلمي عن طريق الثورة أو التحالفات السياسية. ثم يستطرد المؤلف فيذكر أن استخدام السيف أو القوة لتقويم الحاكم أو استبداله هو مذهب السلف. وفي الحقيقة أرى أن هذه المسألة والاختلافات الواردة فيها ليست ذات بال في بناء نظرية التغيير في هذا الزمان ، إذ دعونا نسلم أن استخدام السلاح مبرر شرعاً ، ولا غبار عليه في الفقه ، لكنني أجزم أن ذلك غير ممكن من الناحية العملية والواقعية في هذا الزمان ، كما هو واضح من التوصيف أدناه.
إن التغيير بالسيف والسلاح يستدعي كفاية القوة عدداً ونوعاً ، كما يقول المؤلف ، فهل يعقل أن تحوز الجماعات والأحزاب السياسية وقوى التغيير المجتمعية الأسلحة الآلية والدبابات والطائرات ، كتلك التي تحوزها الدولة بمقدار ترجح الفراسة معه ظن النجاح ، كما يشترط المؤلف؟ وهل توجد دولة أو حكومة عاقلة تسمح لمواطنيها بامتلاك السلاح وحيازته بأنواعه بغرض استخدامه ضدها مستقبلاً؟ ثم من الذي سيحدد إن كان الحاكم مستبداً بدرجة تقتضي استخدام السلاح؟ وماذا لو كانت بعض الأحزاب والقوى السياسية ترى في الحاكم صلاحاً أو أن الظرف الدولي أو الإقليمي يفرض عليه التصرف بطريقة ما ، بينما خالف ذلك وجهة نظر الإسلاميين ، فهل سيثور الإسلاميون على الدولة والقوى المؤيدة لها ، وقد تكون قوى إسلامية ، سلفية أو دعوية أو غيرها؟
أرى أن الصحيح أن نعترف ونقر أن بعض أعلام الفقه الإسلامي يجيزون استخدام القوة ، إذ ليس من المنطق أن يتم الحكم بغير ما أنزل الله في دولة إسلامية ، لكن ليس معنى ذلك أن تتبنى الحركة الإسلامية في منهجيتها هذا الأسلوب في بيئة مغايرة تماماً لتلك التي عاشها المسلمون في العصور الماضية. إن اعتماد منطق استخدام القوة في أدبيات الحركة الإسلامية يعتبر من أهم عوامل ضعفها ، والسبب الرئيسي في الابتلاءات والمحن التي تعرضت لها ، وعجزها عن تكوين التحالفات السياسية ، وحشرها في الزاوية غارقة في الاتهامات ، وفي موضع الدفاع عن النفس. ومن جهة أخرى ، على مر تاريخ الحركة الإسلامية هل استفادت الحركة من تضمين مفهومها في استخدام القوة لتحقيق التغيير السياسي المنشود؟ الجواب على هذا السؤال الهام هو النفي ، بل العكس هو الصحيح. ولننظر إلى بدايات محنة الإخوان في مصر ألم تكن بسبب السلاح؟ ، وكذلك ما حدث في سوريا ومرة أخرى فيما حدث مع الجماعة الإسلامية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وما حدث مع تنظيم الدولة في عدة مناطق في العالم وغيرها. أما حماس التي احتج بها المؤلف في موضع آخر فلم تراكم القوة من أجل إزاحة حاكم ظالم ، وإنما لإزاحة محتل غاشم ، وإنما حصل الإشكال بينها وبين فتح وللطرفين جيشين منظمين تنازعا الحكم والسيطرة وتغلب أحدهما على الآخر. بمعنى آخر ، لقد خسرت الحركة الإسلامية كثيراً ميدانياً وشعبياً ولا زالت تدفع الأثمان السياسية لعدم إقرارها بخطئها في اعتماد مبدأ استخدام السلاح بناء على الآراء الفقهية (التي لا ننكرها). إن أول طريق الإصلاح يتضمن إعادة بناء منهجية التغيير بعيداً عن استخدام السلاح ، مع الإقرار والسعي لتجريم ذلك في مجتمعاتنا ، وإعلان الحركة الإسلامية صراحة عن ذلك ، بل وتسليم أية أسلحة لديها إلى الجهات المختصة كبادرة حسن نية ، عندها تكون الحركة قد انتقلت نقلة نوعية ودخلت عالم التغيير من أوسع أبوابه ، وفي نصوص الشرع البديهية والأساسية ما يؤيد توجهها وما ذهبت إليه ، وستلتف حول دعوتها الجموع.
بالطبع ، أنا أعلم أن البعض لن يعجبه تأويلي ، وأعتبر أن هذا حقه ما لم يعتد على حقوق الآخرين ، لكن دعونا نقلب الصورة لنكتشف أهمية استبعاد استخدام السلاح في مجتمعاتنا المعاصرة. لننظر إلى حالة مصر بعد فوز الحركة الإسلامية وانتخاب الرئيس مرسي رحمه الله حيث رأت جماعات متنوعة بما فيها الجيش أن حكم الإخوان لا يناسب ظروف مصر ولن يحقق طموحاتها (أو أنه يهدد مصالحهم المباشرة) ، فاستخدم الجيش القوة العسكرية ونجح في الإطاحة بالرئيس مرسي وبحكم الإخوان المسلمين ، والسؤال: ماذا لو كانت لدى الإخوان قوة كافية نوعاً وكماً (مع استحالة ذلك) فإلى أين كان من الممكن أن تصل الأمور ومستقبل الدولة؟ وعلى العكس من ذلك ماذا لو عمل الإخوان طيلة السنوات الماضية على بناء ثقافة تداول السلطة ، والتقارب مع الجماعات والأحزاب المؤثرة ، وبناء التحالفات السياسية على أساس مصلحة الدولة والمواطنين ، وتجريم استخدام السلاح ضد المواطنين أو لتحقيق أهداف سياسية ، وتحييد الجيش عن التدخل في السياسة ، هل كان من المرجح أن تصل الحركة الإسلامية في مصر إلى ما وصلت إليه اليوم؟ وبعيداً عن ذلك لنسأل سؤالاً بسيطاً: في الدولة الإسلامية التي يحكمها إمام ورأت بعض الجماعات أنه ظالم أو أنه مستبد فهل من حقها الإعداد للثورة المسلحة وشراء وتخزين الأسلحة الموازية لأسلحة الدولة ، وتشييد مراكز التدريب السرية ، تمهيداً للانقضاض على أركان الدولة إن لم ينفع معها النصح والإرشاد؟ هل يرى عاقل أن هذا الأمر منطقي أو واقعي؟
ثم يختم المؤلف هذا العنوان فينقد نفسه عند قوله أن الجمال سينقذ العالم ، والجمال المقصود هو كل أنواع الجمال بما في ذلك جمال الحرية والصدق والعدل والأخلاق وغيرها ، وليس فقط جمال العمارة والبناء ، والسؤال ، إذا كان الجمال يمكن أن ينقذ العالم فلماذا اللجوء إلى السلاح؟. لكن يجدر هنا التنويه أن الجمال كصورة لا يمكن أن ينقذ العالم ولكن على حركات الإصلاح توضيح أهمية وفوائد الجمال ، وتزيين صورته كي يشعر بها العامة والمثقفين وأصحاب الرأي فيحبونها ، وبالتالي يكونون من دعاتها والمطالبين بها ، فيحدث التغيير.
2. ظاهرة الشباب الضاغط
يذكر الكاتب أن تراكمات الثورة الفكرية المعاصرة (يقصد مجموعة المؤلفات التي قام أعلام الحركة الإسلامية بإصدارها خلال العقود الماضية) وما أسهم فيها المؤلف بما يعرف بكتب إحياء فقه الدعوة ومن تضمنته من شروحات واجتهادات ، كانت الوقود الذي أشعل ثورات الربيع العربي ، ولا ينكر عاقل اسهامات المؤلف في التنظير لأهمية وضرورة التزام الدعاة بأحكام وتعاليم وأخلاق الإسلام ، وأن ذلك مدعاة لرضا الله عز وجل والفوز بجنته ، وفي ذات الوقت يعتبر توطئة للتغيير ومدخلاً للحكم الصالح. وأزيد بأن أسلوب المؤلف كان لافتاً وموفقاً وبارعاً في اختيار وصياغة عباراته بالذات في كتبه الأكثر رواجاً من المنطلق والعوائق والرقائق ، فقد أحسن المؤلف ونال قبولاً وافراً لما ورد فيها من معان وبلاغة وإتقان.
إلا أن المعاني التي حاول المؤلف نسبتها إلى إبداع مؤلفاته في التنبيه إليها لم تكن في نظري جديدة على الفكر الإسلامي والإخواني. فمثلاً من المعروف أن الإخوان لا يؤيدون الانقلابات العسكرية ، ولا حتى الثورات كما جاء في أقوال الأستاذ حسن البنا ، الذي لاحظت أن المؤلف في أكثر من موضع ينزل كلامه منزلة المسلم به من الفقه ، وإن لم يتفق معه فإنه يأوله ويفسره بطريقة قد لا تكون مقبولة من وجهة نظري ، والأصح في تقديري أن ينقد ما يراه شاذاً أو لا يتوافق مع الواقع ، لأن الإقرار بعدم عصمة البنا وأي قائد آخر يعتبر جزءاً من التربية. أما أهمية الشباب وإقدامهم وتضحيتهم فقديم قدم الدعوة ، ففي الحديث "نصرت بالشباب" ، ولا ننسى تولية الشاب أسامة على رأس جيش فيه كبار الصحابة. ولا شك أن دور الشباب في عملية التغيير يعتبر حجر زاوية في النجاح ، لكن من خلال خبرتي فإنني أختلف مع المؤلف في تصدير بعض الشباب للقيادة واتخاذ القرار ، لأني أرى أن هذا مدعاة للفتنة ، ويتماشى مع رغبة جامحة ومطالبات للشباب بتولي القيادة ، مع اتهامات للحكماء والشيوخ بعدم فهم الواقع وعجزهم عن تحقيق الطموحات والنجاحات ، فيتولى قليل الخبرة ، وينشغل بأعمال القيادة وهمومها ويذوب في مشاكلها ، دون أن يأخذ حظاً وافراً من العلم والخبرة والتدريب ، فتكون المصيبة ، لكن لا بأس أن يقتربوا من القيادة دون ممارستها أو يمارسون بعضها تحت رقابة ، والله أعلم.
ثم ينتقل الكاتب إلى معلم آخر من معالم التغيير ، فيذكر أن الدعاة قيدوا أنفسهم بلزوم ما لا يلزم ، وذلك بظنهم – حسب قوله – بضرورة وجود أعداد كافية من الأفراد الذين استوعبوا الفكرة وتقدموا بالبيعة لقادة الحركة ، ويذكر المؤلف أن ذلك ضرب من الخيال ، إذ لا يمكن أن يحدث ، لما للالتزام وشروط البيعة من ضوابط وقيود لا يستطيعها إلا القليل ، لأن الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة. لذلك يستطرد المؤلف بالقول أن الحركة الإسلامية يجب ألا تقتصر على العدد المحدود من أبنائها الذين نالوا حظاً وافراً من التربية والفهم والالتزام ، ذلك لأن هذا العدد مهما بلغ لن يكون كافياً لعملية التغيير كما قدم الكاتب ، وعليه يقترح المؤلف اعتماد مبدأ الولاء للحركة في تقدير قوتها ، بدلاً من اعتماد الأعداد القليلة التي بايعت قيادتها وتدين لها بالسمع والطاعة. لكن هل يرى القارئ فيما تقدم أي جديد ، فقد كان ولا يزال مبدأ الولاء والمؤيدين لفكرة معينة موجوداً على مر العصور قديمها وحديثها ، بل قام رسولنا الكريم بتجهيز جيش لقتال قريش لأنها نقضت عهدها وقتلت رجالاً من قبيلة خزاعة وهم في عقده وعهده الموالين له ، لذلك أقول أن طرح موضوع الولاء لا يضيف أي جديد قدمه المؤلف ليجعل منه قاعدة سماها الولاء بدل الطاعة والبيعة ، فكل الأحزاب والحركات لها قاعدتها الصلبة ولها أيضاً من يؤيدها دون أن يكون عضواً فيها ، والولاء يقتضي النصرة.
ثم يوضح المؤلف ما أورده في أصول الإفتاء والاجتهاد من أن خطة العمل السياسي والجهادي يلزمها أن تتوسع وتكون أكثر مرونة وواقعية لتشمل الاستعانة بأبناء الأمة الذين شغلت ذممهم الدينية ببعض الهفوات الفسوقية والأخلاقية ، وهذا لا يخالف أو يزيد على ما أوردناه من استبدال أو تكامل البيعة مع الولاء ، وقد وصف المؤلف هذه الفئة في مواضع مختلفة من كتابه بالأرباع والأنصاف والأثلاث. إلا أن معضلة الحركة الإسلامية في هذا التوصيف أو الإستعانة أكبر من أن تجبر ، لأنها أباحت لنفسها الاستعانة بمثل هؤلاء أشخاصاً وأحزاباً ، لكنها لا تريد لهم المشاركة بالقيادة والسيطرة ، بل عند النجاح في الوصول إلى الحكم لا تكون الحكومة إلا لها وبالأخص لقاعدتها الصلبة في القيادة ، مما يؤشر على أن مبدأ المشاركة كما تفهمه الحركة الإسلامية يتمثل في استغلال مشاركة الموالين لها وغيرهم في مساندتها وحملها كي تتوسد سدة الحكم ، وهو مفهوم مرفوض ولن يوصل الحركة إلى أي مكان متقدم ، وإن وصلت سرعان ما تعود القهقرى ، لأن الشراكة والمشاركة عامة شاملة. إن قناعة الحركة الإسلامية ومنها المؤلف أن لها الأحقية الطبيعية والمطلقة في قيادة عملية التغيير أو الثورة ومن ثم الحكم تعتبر حجر عثرة في مشروع التغيير ، وعلى الحركة أن تعلن في أدبياتها وتحالفاتها أن نهاية المطاف في عملية التغيير أو الثورة الوصول إلى عملية انتخابية نزيهة ، تتيح للشعب اختيار قيادته وأسلوب حياته ، أما ما عدا ذلك فستبقى الحركة في دائرة الشك والاستبعاد.
وللأسف يكرر المؤلف في أكثر من موضع أن الحركة الإسلامية بنواتها الصلبة وقيادتها المركزية قادت التغيير بنجاح ، وهو كلام مردود بحكم الواقع ، بل الأهم من ذلك وبعد فشل جميع ثورات الربيع العربي تبين أن الحركة الإسلامية ومعها الأحزاب والحركات السياسية والمجتمعية تفتقر إلى خطط التغيير ، وكانت بعيدة عن الواقع ومنفصلة تماماً عن البيئة التي تعيش فيها. ولعلي أعود إلى الوراء لأذكر ما دار في لقائي مع أحد قيادات الحركة الإسلامية والذي كان في زيارة للرئيس مرسي رحمه الله قبل الانقلاب بأيام قليلة ، وقد سألته كيف يرى الرئيس مرسي والإخوان الاحتجاجات ضده ، وما هي درجة تأثيرها وخطورتها على حكم الإخوان؟ فأجابني أن الوضع مطمئن ولا ترى الجماعة أي خطر من تلك المعارضة ، بل على العكس تماماً.
بعد ذلك يناقش المؤلف – وأتفق معه – أنه لا بد من وجود قيادة منظمة للثورة ، تراقب حركتها وتوجهها وتحرص على عدم انجرارها للعنف والقتال أو التخريب ، وهذا بالطبع لا يتأتى في وجود تيار غير منظم أو عفوي ، وإن كنت أرى أن التيار من الممكن أن ينجح في حالة الثورة الخاطفة ، إلا أن مخاطر مصادرة الثورة وانتكاسها تكون كبيرة في مثل هذه الحالة.
أخيراً يتحدث المؤلف عن ضرورة التنمية الشاملة في الانتاج والتصنيع والعلوم والحد من البطالة ، إضافة إلى وجود مشروع حضاري ، مع الاهتمام بإجادة التخصصات المختلفة ، والتربية الإيجابية في جميع مناحي الحياة. إلا أن معظم تلك النشاطات يمكن أن تكون مطلوبة ومهمة لما بعد الثورة وليس مدخلاً لها ، لأن التخطيط وامتلاك كل ذلك منوط بإمكانات هائلة لا تستطيعها إلا الدولة ، وتحقيقها ربما يحتاج إلى أجيال ، بينما يمكن للحركات والجماعات توجيه ثلة من أفرادها لامتلاك المهارات والتخصصات المنوعة ، وتركيز جهودها في التربية والتقويم وتحقيق النجاحات الأخلاقية.
3. شروط تجريبية وظواهر إيجابية
تحت هذا العنوان يعود الكاتب ليؤكد مرة أخرى أن تحقيق الأهداف لا يمكن أن يتم عبر جهود الدعاة (النواة الصلبة) وحدهم ، وإنما أيضاً جهود الأصدقاء والمتعاونين والحلفاء ، إضافة إلى نجاح الحركة في تحييد بعض الفئات ، وبالرغم من أن هذا أمر طبيعي إلا أن المؤلف يستخدمه لسرد ما يقول أنها بنود عديدة في نظرية التغيير ، أجملها بما يلي:
أولاً: في مجتمع من ملايين يكفي تحريك عشرات الألوف للقيام بثورة ناجحة!!!.
ثانياً: وجوب التشدد في معايير الجرح والتعديل عند انتقاء أعضاء التنظيم الخلفي وقادته.
ثالثاً: التربية الدينية الأخلاقية للدعاة والموالين لهم ، لأن الإعداد والتخطيط لا يكفي بل يحتاج من الله مدد.
رابعاً: التخطيط للتغيير جزء من نظريته.
خامساً: الاهتمام بالإعلام.
سادساً: المشاركة النسوية.
بعد ذلك يتحدث الكاتب عن أهمية العمل الجماعي والتفكير المشترك ، ويشبه الحوار والنقاش الجماعي بالسوبركمبيوتر ، وللحقيقة ليس واضحاً لي مراد الكاتب ، إذ أن العمل الجماعي والشورى مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة ، ولا يمكن أن يعتبر المؤلف نفسه أنه اهتدى لما عجز عن الاهتداء إليه آخرون ، فيدعي أنه اهتدى إلى استحضار عبقرية خارقة وليس مجرد ذكاء!!! ، وكأن الكاتب يخاطب قراء من غير هذا العالم.
ويعود المؤلف ليثبت تناقضاً جديداً عندما يدعي أن الثورة المصرية لم تنجح بسبب ذلك المتظاهر الذي يحمل الحاسوب ويبث الصور ومقاطع الفيديو (كما هو مقرر في تنظير التغيير الذي قدمه الكاتب والذي يعتبر الإعلام الرقمي حجر زاوية فيه) ، ولكن لأن خطة اللواء طنطاوي التقت مع رغبات ذلك الشاب "فأراد أن يتغدى بمبارك قبل ان يتعشى به" ، بينما يعتبر المؤلف أن النشاط التنظيمي التراكمي الذي قدمته الدعوة كان "السبب الثاني" في النجاح!!!.
وفي نفس السياق يقول المؤلف أن ما عند الإخوان من تربية علمية وإيمانية ترفعهم عند الاختلاف عن السلوك التنافسي المعيب ، وأن الإخوان تحكمهم آداب الخلاف وفقهه ، ومنها الابتعاد عن تجريح الأفراد والهيئات والمؤسسات ، ويلتزمون قول البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. لكن للأسف ، هذا لم يمنع الكاتب نفسه من كيل التهم والتجريح لشخصيات محترمة ، تبوأت أعلى المناصب القيادية ، حتى من الإسلاميين من أمثال عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا وكمال الهلباوي ، بسبب اجتهادات يمكن استيعابها ، وكذلك ما طال حزب النور من انتقادات لاذعة على لسان المؤلف ، ويمكن مراجعة كتابه الردة عن الحرية لمعرفة المزيد.
ويستطرد المؤلف فيذكر ضرورة الاستفادة من الغوغاء (عامة الناس) في الضغط والتأثير ، ويجب الاستعانة بهم دون منحهم القيادة والصدارة ، لأن سلسلة المنافع لا تكتمل بدونهم. وللأسف أرى أن التعبير قد خان المؤلف هذه المرة أيضاً ، فألحق بهذه الفئة أوصافاً دونية لا تليق ، ومن ذلك قوله أن على الرؤساء التعامل معهم بحسب "قيمتهم" ، وأنه لا يليق أن تحويهم صفوف الدعاة ، وأن على الحركة أن تقترب منهم ، وأن يجمع الدعاة شظايا الخير فيهم مهما كانوا فساقاً في القياس الشرعي ومهما كانوا أصحاب نقص فطري وقلة ذكاء وضعف في القدرات!!!. بالفعل كلام غريب ، ولذلك قد تحتاج الحركة إلى دائرة خاصة تقوم بتصنيف الناس فهؤلاء أنصاف وأرباع وأخماس وأسداس ، وأولئك من الغوغاء ، وفئة ثالثة من الموالين ، ورابعة وخامسة كذا وكذا!!!.
وبعد إعادة تأكيد الكاتب على أهمية الإعلام ، يعود ليكرر ضرورة تكوين جيل من علماء الشريعة القادرين على الاجتهاد والاستنباط ، ويختم هذا العنوان بالحديث عن الأزمة العراقية ومؤامرات أمريكا ، والدور الإيراني وحزب الله في العراق وسوريا ، وضرورة التأكد من استبعاد نظرية التغيير لأي دور لهما (يقصد إيران وحزب الله).
4. حركة الحياة تغيير
أهم ما يقدمه المؤلف تحت هذا العنوان يمكن أن يكون تقديمه لمعيار "الحرية أولاً" ، لأن ديدن الحركة الإسلامية التركيز على أن الإسلام أولاً ، وهي جدلية فكرية تتعلق بإيهما نبدأ ، والصحيح أن الحرية تقود إلى اختيار الإسلام والمطالبة بتطبيق أحكامه ، وأن المطالبة بالحرية تشترك فيها جميع قوى التغيير ، مما يوجد الأرضية المشتركة للتعاون ، ويختصر الطريق إلى زوال الأنظمة الفاسدة ، خاصة مع إقرارنا أن تغيير المنظومة الحاكمة وتطبيق الإسلام هو خيار شعبي يعتمد على الحرية. لكن على الجانب الآخر ، هناك عدد وافر من أبناء الحركة الإسلامية تبنوا هذا الرأي في فلسفة التغيير ، وهو ليس بالأمر الجديد ، لكن أن يأتي ذلك على لسان المؤلف يعتبر أمراً غاية في الأهمية من وجهة نظري. ثم يذهب الكاتب إلى أبعد من مجرد تبني شعار الحرية أولاً إلي مطالبته بتهيئة الظروف والأدوات والتربية الكفيلة بترسيخ مفاهيم الحرية حتى يعشقها الشعب ، وبالتالي يزداد حرصه عليها ومطالبته بها.
كذلك أشار الكاتب إلى أهمية اكتساب الدعاة للخبرة في استخدام وسائل التواصل والانترنت ، لأنها لغة العصر ، ولضرورة إزالة الحواجز بينهم وبين الشباب الذي تربى في بيئة الحاسوب والانترنت ، وبديهي أن ذلك مطلوب وطبيعي للغاية.
5. المعجزة الشبابية
يبدأ المؤلف بالتساؤل خاصة بعد هذا العمر الطويل للحركة الإسلامية دون تحقيق التمكين ، وعدم قدرتها على تجاوز كونها نخبة في تركيبتها التنظيمية: هل القلة المؤمنة مؤهلة للإصلاح والتغيير ، وإلى متى تستمر الحركة في دعوة الناس دون نتيجة تذكر؟.
ويجيب المؤلف على تساؤله من واقع ما ورد من قصة موسى مع قومه ، ويخلص إلى ضرورة الاستمرار في المحاولة والسعي إلى التغيير ، فإن لم يستجب قوم ربما استجابت ذريتهم في المستقبل ، مع إيلاء أهمية كبرى لدور جيل الشباب في عملية التغيير.
بعدها يتحدث المؤلف عن التجربة التركية ، ويحاول تفسير لماذا نجح الخيار السلمي المحض فيها ، ثم يستنتج أن الدعاة في سائر البلاد الإسلامية عليهم اتباع الأسلوب السلمي لأنه الأصل ، وأن استعمال القوة استثناء توجبه الضرورة فقط. وهنا لا يزال المؤلف واقعاً تحت سطوة وسيطرة القناعة بإمكانية استخدام القوة في عملية التغيير ، وأتمنى أن يراجع فكره في هذه القضية لأن مجرد امتلاك القوة (فضلاً عن استخدامها) يعني كتابة شهادة وفاة للتنظيم والحركة التغييرية ، لأن العاقل لا يختار الساحة والسلاح التي يتفوق فيهما خصمه ، هذا بالإضافة إلى أن الواضح أن عمليات التغيير السلمي ممكنة ، وأن عدم النجاح ناشئ عن بعض الأخطاء ، أو أن الإعداد والتهيئة لم تكن كافية.
ويبدو المؤلف معجباً ومؤيداً لعملية التغيير على الطريقة التركية ، التي يقول أنها أضافت ثلاثة إضافات لنظرية التغيير ، وذلك من خلال نموذج قوي من الخدمات المدنية والتنموية ، ورفعها لشعار الحرية أولاً ، إضافة إلى الحد الأدنى من مراعاة مصالح أميركا. لكنه يعود ليذكر بعض أخطاء أردوغان ، ومنها ما يعتبره أكبر سقطاته عندما ذهب إلى خطأ حماس في قرارها رفض الصلح الدائم وعدم اعترافها بإسرائيل التي هي حقيقة واقعة حسب قوله. لكن هل أردوغان الوحيد الذي يقول بذلك؟ بالطبع هذا يتوقف على فهمنا للسياسة وطبيعتها الديناميكية ، حيث أن الثابت الوحيد فيها أنه ليس فيها ثوابت ، وأن موازين القوى على الأرض هي التي ترسم الحدود. وللعلم ، فإنه في أحد المؤتمرات الدعوية التي عقدت في أمريكا وحضرها عدد من كبار قادة الحركة الإسلامية ، فقد أفتى مجتهد من قيادات الحركة الإسلامية المصرية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي خلال نقاش موضوع جواز الاعتراف بإسرائيل ، حيث قرر أن ذلك جائز شرعاً ، وأن التوقيع على العقد لا يعني شيئاً لما فيه من الإكراه ، وأن المسألة كلها سياسية في أصلها. أما الخطأ الثاني من وجهة نظره فتمثل في وساطته بين أميركا والفصائل الجهادية العراقية لإنهاء القتال والانضمام إلى الحكومة ، وعدم انحيازه للمقاومة. وهذا أيضاً مردود عليه بأن تركيا تمارس دور إقليمي من خلال الوساطات ، ويجب أن يكون واضحاً أن كل طرف (وليس الوسيط) هو الذي يحدد مصالحه ، والمدى الذي يمكن أن يذهب إليه. إضافة إلى أخطاء أخرى من وجهة نظر المؤلف ، لكن أعتقد أن أردوغان – وإن لم يكن منزهاً عن الأخطاء – كان ينفذ السياسة التي تتوافق مع مصالح بلاده ، وأنه في العديد من القضايا غير سياسته أو عدلها لتستجيب لتلك المصالح ، كما لا يمكن لأحد أن يتوقع أو يعلم يقيناً انعكاس المواقف المغايرة على تركيا ، فيما لو تم اعتمادها.
أنتقل الآن إلى بعض المفاهيم التي بسطها المؤلف فس كتب أخرى ، وذلك لما لها من علاقة وطيدة بفلسفة التغيير.
التخطيط الاستراتيجي مقابل الخبرة التنظيمية
لا شك أن القارئ لكتاب رؤى تخطيطية سوف يستغرب كيف يمكن لتنظيم كبير الحيود عن مبادئ ومقتضيات التخطيط الاستراتيجي ، بذريعة الخبرة المتراكمة التي تولدت لدى عناصر التنظيم المنشغلين في الدعوة منذ عقود. ذلك لأن أولئك الدعاة لا بد وأن يكونوا أسهموا في بناء الخطط الاستراتيجية ، وشاركوا في صياغتها ، وقدموا كل ما يملكون من خبرات لإنجازها في أبهى صورة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تشعب قضايا التخطيط الاستراتيجي وعدم حصرها في زاوية واحدة أو زوايا قليلة قد يكون أحد الدعاة بارعاً فيها ، لكن المؤكد أنه لن يكون متمكناً من جميع أصولها وفروعها وترتيبها الزمني وأدواتها المطلوبة وغير ذلك مما يعلمه المشتغلون في هذا المجال. جاء في كتاب رؤى تخطيطية ما يلي: وأما الدعاة فهم أصحاب قضية مشتركة ، وتطورت العاطفة عندهم إلى عقيدة ، ولهم امتداد تاريخي ومكاني ، فصارت الحصيلة الخاصة (يقصد الترسبات التجريبية) شطراً موازياً مساوياً لعلم التخطيط العام ، ولهم أن يرفلوا بمفاد المعاناة التي خضعوا لها فإنها يقين ، والوصايا الواردة في الكتب ظن وتخمين. ثم يقرر الكاتب أن الموظف الحكومي هو الذي ينصح بالتقيد بالوصايا التخطيطية العالمية ، وكأن الموظف الحكومي ليست لديه أضعاف تلك الترسبات التجريبية - التي حازها الدعاة - نتيجة القضايا اليومية التي يعاركها طوال عمله في وظيفته!!!.
إن هذا المنطق في تقديم الخبرة (التي من الممكن لكثيرين ادعائها في المجال الدعوي تحديداً) على مكانة التخطيط الاستراتيجي ، والإيحاء باختيارية التزام الدعاة بالوصايا التخطيطية يعتبر أمراً خطيراً ، ولا شك أن الحركات الإسلامية التي تتبنى هذا الفهم غير المنضبط والذي لا يمكن متابعته ، أو محاسبة من يتبناه يعتبر خرقاً لقواعد أصول الإدارة ، ويساوي التخبط والفوضى.
ثم يعيد الكاتب تأكيد رؤيته في تقديم الخبرة على التخطيط فيقول: ونحن (يقصد الحركة الإسلامية) نحترم الحقيقة التخطيطية ، ونذعن للمرئي من حياة الشعوب والجماعات وحركات الجيوش والساسة من ضرورة السيطرة على ساحة العمل ومعطياتها ، واعتماد خطة واضحة الأركان قبل التقدم ، ولكن الأثر القيادي عندنا نراه أنفذ من التخطيط وأبعد في التحكم والتغيير. ويتابع بما هو أعجب فيقول: ويزداد هامش هذا التأثير إذا اكتسبت القيادة شحنة عاطفية يراها التابعون صورة من صور الإلهام والتوفيق الرباني الذي تحمله الملائكة لكل مؤمن يتفانى ويخلص من أجل رفعة أولياء الرحمن في الحياة الدنيا. إذاً ليس فقط تقديم الخبرة ، ولكن أيضاً الإلهام والتوفيق الرباني ، والسؤال: الخبرة قد يمكن تحديدها بشكل أو بآخر ، إلا أن الإلهام والتوفيق الرباني أمر لا يمكن قياسه لتحديد درجته ، لأن كل مؤمن لديه درجة أو صورة ما منه ، لكن أن يتم تقديم كل ذلك على النهج التخطيطي فإن ذلك يعني باختصار وضع القرار كاملاً في يد القيادة ، حيث الطبيعي أن لا ينازعها أحد في الخبرة والدراية والإلهام والفتح الرباني ، وعلى التخطيط السلام.
ويؤكد الكاتب استنتاجاته وقناعاته حيث يقول: نحن جماعة مؤمنين ارتضوا مؤمناً منهم يجتهد وهم حوله رقباء ومساعدون. ولذلك يكون الأداء القيادي أبعد أثراً من التخطيط في محيطنا ، وهذه ظاهرة في الحياة الدعوية تترجح فيها الإرادة القيادية على الالتزامات التخطيطية بشكل تلقائي غير متكلف ، وهذه التلقائية في منح القيادة نقطة امتياز على السلطة التخطيطية هي جزء من تلقائية أوسع تظهر في المحيط الدعوي. وكأننا في عصر الوحي وصدر الإسلام وعلى بعد مئات السنين مما شهده التطور الإداري والتخطيطي ، حتى يتم تقديم رأي الواحد أياً كان على رأي الجماعة ، لأن التخطيط عمل جماعي ويمكن النظر إليه على أنه شكل من أشكال الشورى ، خاصة وأن عدداً كبيراً من القيادات شاركت في صياغته ، ولم يتم اعتماد مخرجاته دون أخذ آراء الجهات القيادية العليا بعين الاعتبار. باختصار ، فهم مغلوط وخطير لمنزلة التخطيط ، وذلك أقصر طريق للفشل.
اتخاذ القرار
في كتاب الاستنباط الاستراتيجي يقر المؤلف بصعوبة التعامل مع مجموعات كبيرة من المعلومات والحقائق ، وبالتالي صعوبة تحويلها إلى جملة قرارات دون اللجوء إلى أسلوب علمي رصين لجمع الحقائق المتناثرة وربطها وجعلها في معادلات ، ونحن بذلك بحاجة إلى إطار نظري لا بد من استعارته من علم الاستراتيجيات والإدارة لاختيار القرار الأمثل ، بما في ذلك استخدام الرياضيات لقياس المزايا الصافية للبدائل والوصول إلى قيمة واحدة لكل بديل ، يكون القرار قد اتخذ ضمنياً ، ويصبح الاختيار عملية بسيطة تافهة.
ولعلي أشير هنا إلى أن الكاتب بحديثه عن صعوبة الوصول إلى قرارات صحيحة في وجود كم هائل من المعلومات قد أصاب كبد الحقيقة. لكن أجدني مضطراً إلى بعض التفصيل لتوضيح المسألة ، حيث أصبح معلوماً أن اتخاذ القرار غالباً ما يكون سهلاً ويحتاج إلى جهد بسيط في بعض الأحيان ، ولكن المشكلة ليست في اتخاذ القرار في وجود معلومات وتناقضات ، وإنما في صناعة القرار ، لأن صناعته هي في الحقيقة عملية متكاملة تتطلب الجهد والوقت واللجوء إلى النظريات الرياضية الملائمة ، وعندما يتم تقييم البدائل كخطوة من خطوات صناعة القرار ، تكون آخر خطوة وثمرة تلك الصناعة اتخاذ القرار ، الذي بالفعل يصبح واضحاً واتجاهه معلوماً ، وإلا نكون بحاجة إلى إعادة التقييم باستخدام أدوات إضافية.
وحيث أن أي قرار يحتوي على مخاطرة ، فإن الكاتب يشير في فقرة أخرى إلى ذلك بقوله: والاستراتيجيون يحاولون اصلاح عيب عدم المخاطرة بإضافة عامل المعايير التي تصف الواقع والخيارات بأحكام أكثر تفصيلاً ، (يقول الكاتب) هكذا أفهم المعايير. وهي تقييد للمبدع فيما أرى ، وأرى أنه لا حدود لهذه المعايير ، وإنما هي قضية استنباطية وتكون على درجات من الأهمية. ويتابع بقوله: وهكذا تكون عوامل اتخاذ القرار ثلاثة: درجة السيحان واستقطاب الأهداف أثناء البحث وتحكيم المعايير الموضوعية ، وبالنسبة للمسلم تقوم جميع الكتلة الإيمانية والشرعية والتفسيرية للقرآن الكريم كقاعدة تحتية للمعاييرالموضوعية التي يقيس بها ، وإذا أخلى ذهنه من هدف وانتظره أثناء البحث ، وهي عملية نفسية سهلة: فإن فن اتخاذ القرار عنده سينحصر في الاستعداد لالتقاط الصواب من خلال التأمل الحر السائح وانتظار ومضات الإبداع واستعراض الصور الوصفية لأجزاء الحياة ودرجات نبضاتها ، وتكون كل القصة أسهل عليه من تعقيدات الاستراتيجيين ، وذلك الذي أريده لدعاة الإسلام حين وضعت لهم نظرية حركة الحياة.
أما تعقيبي على ذلك ، فإنني أشير إلى أن الاستراتيجيين الذين أفتوا بضرورة صناعة القرارات وعدم الركون إلى الخبرة أو التفكر والتأمل الحر فقط ، أولئك بنوا فلسفتهم على أن بيئة القرار تحوي عدداً من الأهداف وعدداً آخر من البدائل ، وقد يتطلب الأمر أن يستجيب القرار لعدد من المعايير (ليس بالضرورة طبعاً أن تكون شرعية) ، وعليه فإن موضوع المفاضلة بين البدائل يتطلب عرض كل منها على مجموعة كبيرة من المتغيرات في نفس الوقت ، وهو ما لا يحسنه العقل البشري ، ويحتاج إلى حاسوب. ففي علم الرياضيات من المعروف أننا بحاجة لعدد معادلات يساوي عدد المتغيرات المراد حساب قيمتها ، ورياضياً أيضاً من غير المفيد محاولة حل ثلاث معادلات كل منها تحتوي على ثلاث متغيرات يدوياً لأن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً ، والأفضل استخدام حاسوب فما بالنا بعشر معادلات وعشر متغيرات مثلاً؟. لذلك عندما نتحدث عن عملية صناعة القرار وما فيها من متغيرات كثيرة ، فإن استخدام التأمل الحر أو انتظار ومضات الإبداع لن تكون لها قيمة ، ولا يمكن استخدامها إلا في القرارات البسيطة (التي لا تحتاج إلى صناعة) من أمثال نوعية القصص التي يعرضها الداعية في ندوة معينة ، أو ماذا يلبس الداعية عند إلقائه خطبة الجمعة ، أو هل يذهب الداعية إلى المسجد ماشياً أو راكباً. لكن قراراً من قبيل هل تشارك الحركة في الانتخابات أم لا؟ أو هل تدخل الحركة الانتخابات منفردة أم ضمن ائتلاف؟ هل تقوم الحركة بإنشاء نادي رياضي أم مستشفى؟ وغير ذلك مما يستدعي صناعة قرار يستجيب لمصالح الحركة بشكل أفضل. إذاً ، القضية لا تتعلق بتربية او خبرة أو إلهام مقابل تعقيدات الاستراتيجيين او ضرورة الدخول في عملية صعبة ، وإنما هي طبيعة الأشياء ولزوم ما يلزم ليس إلا.
الرؤى والإلهام
في كتاب صناعة الحياة يشير الكاتب أن ظاهرة السيطرة المستقبلية ، وخلاصتها أن الله تعالى قد أذن لبعض خلقه أن يعلم بعض العلامات والقرائن الدالة على ما سيحدث في المستقبل من غير جزم ، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ، ولكن بنوع من الترجيح يقذف طمأنينة في قلب المؤمن ، فيتصرف تصرفاً هادفاً متناسباً مع ما يتوقعه من الأحداث ، فيسيطر بذلك لا على يومه فقط وإنما على المستقبل أيضاً.
وأستغرب لماذا يسرد الكاتب هذا الكلام ، فإن كان بغرض تشجيع سائر المؤمنين على اتباع قلوبهم وهداية ربهم التي يعرفونها بعلاماتها وعايشوها سابقاً ، فهذا أمر لا يحتاج إلى تذكير ، لأنها طبيعة الأشياء ، وكل إنسان أدرى بما يصلح شأنه (من وجهة نظره على الأقل). لكن طبيعي أن تندمل في ثنايا هذا الكلام مشكلة كبيرة إن قصد الكاتب من كلامه هذا تغليب الإلهام على التخطيط ، ونزوع الجماعة إلى اعتماد تلك الالهامات (!!!) لاتخاذ القرارات في الشأن العام.
وللأسف ، فقد أوضح المؤلف رأيه في ذلك فقال: الرؤيا الصالحة والإلهام جزء من قراءة المستقبل ، وللمؤمن أن يركن إلى بعض ما يراه ، وللمؤمنين وأمرائهم أن يركنوا إلى رؤيا أخ لهم معروف بصدق الرؤيا إذا أخبرهم أنه رأى علامة صدقها ، فيفعلون أمراً متناسباً مع مفاد الرؤيا ، أو يمتنعون عن فعل نووه مما هو داخل في نطاق التخطيط والمواقف والقرارات.
وتعقيباً على ذلك أقول أنه بالفعل هناك إلهامات أو رؤى يراها بعض الناس وتأتي كفلق الصبح ، وأرى أن على الشخص المعني أن يتبعها فإنها علامة وآية خاصة به ، إنما لا يسع الجماعة اعتماد تلك الالهامات والرؤى إن خالفت التخطيط وأساليب الإدارة الحديثة. وقد تواردت أخبار وروايات كثيرة لقيادات وأفراد من هؤلاء الذين يدعون الالهام والرؤى الصادقة (وأعتقد شخصياً أنهم لامسوها أكثر من مرة) لكن عندما تم اعتمادها كمصدر للحقيقة لم تكن صادقة مطلقاً. ومن ذلك ما يعرفه البعض من الشك بل واتهام بعض الأفراد بالعمالة للمحتل وتعريضهم لأشد أنواع التعذيب وربما القتل ، بناء رؤيا تبين أنها من شيطان رجيم ، لا من رحمن رحيم. خلاصة القول ، العمل الجماعي تحكمه قوانين وأنظمة وخطط استراتيجية ومرحلية ، ومن الخطر الشديد في الفهم والتطبيق الحديث عن الرؤى والإلهامات كأسس للتحرك واتخاذ القرارات ، لكن على المستوى الفردي فكل إنسان أدرى بنفسه ، وليس بينه وبين الله ترجمان ولا وسيط.
في الختام ، أعتقد أن الخلاف في بعض القضايا الجزئية لا يفسد للود قضية ، خاصة عندما يكون ذلك في الأمور السياسية الاجتهادية ، وإن كنت أرى الكثير من المعاني الإيجابية التي وردت في كتب المؤلف المختلفة ، بالذات كتب التربية الإسلامية والأخلاق والتحفيز ، وأعترف بفضل الكاتب في تقديم سرديته فيها بأسلوب مبتكر ومميز ، وكنت سأسعد كثيراً في مناقشته فيما كتبت عوضاً عن النشر ، ولكنها أمانة الكلمة وما فرضته تعقيدات الحياة خاصة علينا في فلسطين.
لكن بلا شك تفتقر بعض تلك الكتب التي تناقش السياسة والتغيير والاستراتيجيات والإدارة والعمل العام إلى من يسبر غمارها ، ويجمع ما تناثر في ثنياتها من قضايا محددة لتأصيلها أو وضعها ضمن النظريات الحديثة ، وبما ينسجم مع التطور الفكري والإداري ، أو ينقدها ويصحح مفاهيمها ، بالنقاش الهادئ والدليل المنطقي والعقلي والتجريبي ما أمكن.
إن بناء وصياغة نظرية التغيير بفرضياتها وقوانينها وبنودها وقيودها وخطتها العامة ممكن ، ولا شك أن بعضاً منه تناثر في الكتب المختلفة للمؤلف وغيره ، ومن المتوقع أن يسهم في تطور الفكر الإسلامي كثيراً من خلال إجابته على مجمل التساؤلات المتعلقة بعملية التغيير ، آخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية ، وتطور الفكر الإسلامي ، والكفاءة المستمدة من الدراسات العلمية ذات الصلة ، ونظريات التغيير المنشورة على الشبكة العنكبوتية.